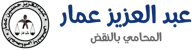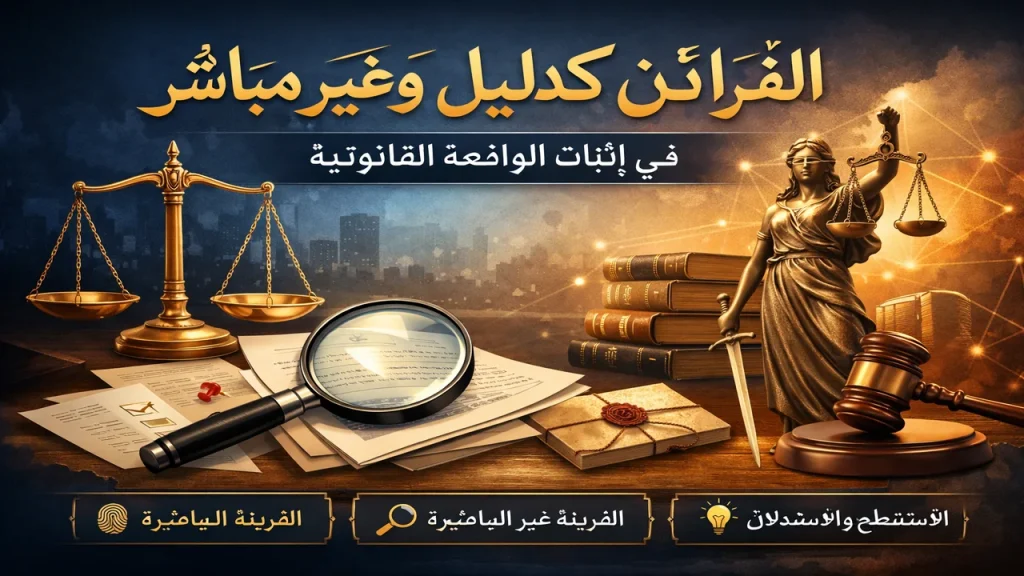📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
بحث قانوني عن أهمية القرائن كدليل مباشر وغير مباشر فى اثبات الواقعة القانونية، وذلك فى الدعاوي المدني، وفقا لقانون الاثبات المصري، وأحكام محكمة النقض عن القرائن بأنواعها.
دليل مرتبط: نصاب البينة عند تغيير القانون وتأثيره على القرائن
لفهم العلاقة بين القرائن ونصاب البينة عند تعارض القانون القديم والجديد، راجع الدليل التالي الذي يحدد متى نقيس النصاب وأي قانون يحكم الإثبات.
اذن، الدراسة البحثية، تتناول :
معني القرينة القانونية، والقضائية، التى يلجأ اليها المدعى فى اثبات دعواه، ويلجأ اليها المدعى عليه فى نفي ادعاءات المدعي، وتتناولها المحكمة بالفحص والتمحيص، للوصول الى وجه الحق في الدعوى القضائية.
الدعاوي الجائز اثباتها بالقرائن كدليل مباشر وغير مباشر
- كافة الدعاوي القضائية المدنية، يجوز اثباتها بالقرائن، سواء كانت قرينة قانونية، أو قرائن قضائية.
- مع العلم أن القرينة القانونية، أقوي في الاثبات، لأنها بنص القانون الموضوعي .
القرائن كدليل مباشر في إثبات ونفي الدعوي
القرائن هي الدليل الرابع في سلسلة الأدلة المقبولة في إثبات ونفي التعاقد موضوع دعوى الصحة والنفاذ ، وأي واقعة قانونية فى أى دعوي مدنية.
تعريف القرينة
القرينة لغة تعني الارتباط والصلة:
- فيقال : قرن الشيء بالشيء ، أي وصله به وبابه ضرب ونصر .
- ويقال : قرن بين الحج والعمرة أي جميع بينهما .
- ويقال : قراًنا أي جمع بينهما
وتعرف القرينة اصطلاحا بأنها
استنباط الشارع أو القاضى لأمر مجهول من أمر معلوم ، وهى علي هذا النحو دليل غير مباشر لأنها لا تؤدى إلى ما يراد إثباته مباشرة ، بل تؤدى إلى إثباته بالواسطة أو بالأمر المعلوم .
فالقرينة طبقاً للتعريف السابق
تواجه أمر معلوم – عليه دليل – ليستنتج أمر غير معلوم – ليس عليه دليل – فإذا ثبت الشيء المعلوم ، أي قام عليه الدليل ، ثبت تبعاً له الشيء غير المعلوم .
مثال ذلك
القرينة المنصوص عليها فى المادة 19 من قانون الإثبات التي تنص على أن التأشير على سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين ولو لم يكن موقعا من الدائن.
- هذا هو الأمر المعلوم : يؤدى إلى استنتاج براءة ذمة المدين .
- وهو الأمر المجهول: لعدم توقيع الدائن والتأشير أو عدم إعطائه المدين مخالصة موقعة إلا في حالة المخالصة الفعلية أو الحقيقية .
وقد عرفت محكمة النقض المصرية القرينة بقولها
القرينة وبحكم اللزوم العقلي وطبائع الأشياء هي استنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة معلومة القرينة بحيث إذا كانت هذه الواقعة محتملة وغير ثابتة بيقين فإنها لا تصلح مصدرا للاستنباط .
هل تعد القرائن وفق التعريف السابق دليل اثبات؟
إذا قلنا أن القرينة دليل ، دون أن نضيف أنها دليل غير مباشر ، كان القول غير دقيق ، فالقرينة كما ذكرنا تقوم علي استنباط الشارع أو القاضى لأمر مجهول من أمر معلوم ، الأمر المجهول ليس عليه دليل.
والأمر المعلوم قام عليه دليل ، وثبوت الأمر المعلوم بدليل عليه ، يؤدي إلى ثبوت الأمر المجهول للعلاقة المنطقية التي تقوم بينهما.
وعلي ذلك تعد القرائن دليل غير مباشر لأنها لا تؤدى إلى ما يراد إثباته مباشرة ، بل تؤدى إلى إثباته بالواسطة أو بالأمر المعلوم .
وفي بيان موقف محكمة النقض من اعتبار القرائن دليل غير مباشر، قضت
ما يجوز إثباته بالبينة يجوز أيضا إثباته بالقرائن و لمحكمة الموضوع حرية اختيار طرق الإثبات الذي تراه موصلاً للكشف عن الحقيقة مادام الإثبات جائزا بجميع الطرق .
كما قضت محكمة النقض
إذا كان يجوز إثبات واقعة التوقيع على الورقة العرفية بشهادة الشهود على ما تقرره المادة 274 من قانون المرافعات .
فان إثباتها بالقرائن يكون جائزا أيضا عملا بالمادة 407 من القانون المدني .
كما قضت محكمة النقض
تقضى المادة 399 فقرة 1 من القانون المدني بأن التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلي ان يثبت العكس .
ولو لم يكن التأشير موقعا منه مادام لم يخرج قط من حيازته والتأشير المشطوب يبقى حافظا لقوته فى الإثبات وتقوم به قرينة الوفاء على الرغم من الشطب إلا إذا نقضها الدائن بإثبات عدم حصول الوفاء وان الشطب كان سبب مشروع .
واعتبار القرائن دليل ولو كانت دليل غير مباشر أمر لا يخلوا من خطورة عبر عنها قضاء محكمة النقض
القرائن على العموم – ما عدا القرائن القانونية القاطعة علي نحو ما سيلي – أقل ضمانا من غيرها لأنها استنتاجات ، وكثيرا ما تكذب ظواهر الأمور .
وما أكثر خطأ الإنسان فى استنتاجاته منها.
ولذلك لم يبح الشارع الإثبات بالقرائن إلا حيث نص على ذلك نصا صريحا فى أحوال تبرر ذلك ، أو فى الأحوال قليلة الأهمية أو عند الضرورة .
كما هي الحال فى الإثبات بالشهود ، ولذلك يجوز إثبات ما يخالفها بجميع طرق الإثبات بما فى ذلك شهادة الشهود والقرائن .
ويجمل الدكتور عبد الحكم فوده القول
تختلف القرينة القضائية عن القرينة القانونية فى أن الأولى تعتبر دليلا إيجابيا فى الإثبات ، وان كانت دليلاً غير مباشر ، هي أولا دليل إيجابي ، لان الخصم يتوسل بها إلي إثبات دعواه .
وعليه هو ان يستجمع عناصرها ويلم شتاتها ويتقدم إلي القاضى باستنباط الواقعة المراد استخلاصها منها ، والقاضي يعد حر في مساير الخصم.
فقد يسلم بثبوت الواقعة التي هي أساس القرينة وقد لا يسلم ، وقد يقر استنباط الخصم وقد لا يقر ، ولكنه على كل حال ليس ملزما ان يستجمع هو بنفسه القرائن .
وان كان للقاضى ان يأخذ من تلقاء نفسه بقرينة فى الدعوى لم يتقدم بها الخصم ، والقرينة القضائية ثانيا دليل غير مباشر ، لان الواقعة الثابتة ليست فى نفس الواقعة المراد إثباتها .
بل واقعة أخرى قريبة منها ومتعلقة بها ، بحيث ان ثبوت الواقعة الأولى على هذا النحو المباشر يعتبر إثباتا للواقعة الثانية على نحو غير مباشر .
اما القرينة القانونية، هي ليست دليلا للإثبات ، بل هي إعفاء منه فالخصم الذي تقوم لمصلحته قرينة قانونية يسقط عن كاهله عبء الإثبات .
إذ القانون هو الذي تكفل باعتبار الواقعة المراد إثباتها ثابتة بقيام القرينة ، وأعفى الخصم من تقديم الدليل عليها ، وتستوي فى ذلك القرينة القانونية القاطعة والقرينة القانونية البسيطة .
فسنرى ان القرينة القانونية البسيطة هى أيضا إعفاء من الإثبات ، وان جواز إقامة الدليل على عكسها ليس الا نزولا على اصل من الأصول الإثبات يقضى بجواز نقض الدليل بالدليل .
والقرينة القانونية تعفى من الإثبات فى الدائرة التي رسمها لها القانون ، لو فى تصرف قانوني تزيد قيمته على ألف جنيه أي في دائرة لا تقبل فيها القرينة القضائية .
هل تلزم محكمة الموضوع بالإحالة إلى التحقيق إذا كان إيضاح القرينة يتم من خلال سماع شهود؟
أجابت محكمة النقض
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلي التحقيق مادامت قد وجدت فى الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين اعتقادها ولا يعيب المحكمة اعتمادها على أقوال شهود سمعوا فى غير مجلس القضاء.
لان المرجح فى تقدير تلك الأقوال كقرينة قضائية هو اقتناع قاضى الموضوع على ان المجادلة في هذا الخصوص تتعلق بتقدير الدليل فى الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع .
كما أجابت محكمة النقض
إذا كانت محكمـة الموضوع قـد اتخذت سبيـل الإثبات بالقرائن على الوضع الذي أجازه فيه القانون.
فان لا عليها ان هي لم تأمر بالإثبات بشهادة الشهود استنادا إلى الرخصة المخولة لها بالمادة 70 من قانون الإثبات.
لان هذا الحق جوازى متروك لرأيها ومطلق تقديرها .
الأحكام الخاصة بالقرائن كأدلة غير مباشرة
وفي بيان الأحكام الخاصة بالقرائن يجري نص المادة 99 من قانون الإثبات :
القرينة القانونية تغني من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات .
على أنه يجوز أن تقضي هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
كما يجري نص المادة 100 من قانون الإثبات على أن :
يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجوز فيه الإثبات بشهادة الشهود .
ويستفاد من هذين النصين أن القرائن نوعان
- النوع الأول : قرائن قانونية : وهي قرائن نص عليها المشرع صراحة .
- النوع الثاني : قرائن قضائية : وهي تلك القرائن التي يقوم القاضي بما له من سلطة في استنباطها .
القرائن القانونية كدليل اثبات
القرائن القانونية هي القرائن التي نص المشرع عليها ، أي حملها نص تشريعي ، سواء في قانون الإثبات أو في أي قانون آخر .
ونكون في مواجهة قرينة قانونية طبقاً لفكر الشارع المصري في كل حالة يثبت فيها قيام واقعة قانونية معينة ، بأن قام عليها دليل قرينة .
فيقرر المشرع اعتبار ثبوت تلك الواقعة دليلاً علي ثبوت واقعة أخري ، فنكون عندئذ بصدد ما يسمى بالقرائن القانونية .
ما هو السبب الذي حدا بالمشرع المصري إلى إقرار هذه القرائن القانونية كأدلة أسس اختياره لها؟
القرائن القانونية علي نحو ما قدمنا عمل تشريعي بمعني أن المشرع هو الذي يقرها وينتقيها ولذلك سميت قانونية.
ويرجع تقديره لها انتقاء واختيراً إلي عدة مبررات أهمها :
المبرر الأول : ما يلاحظه الشارع من أحوال الناس وطبائعهم وعادتهم فى معاملاتهم وما تواضعوا عليه وعلى وجه العموم.
فمثلا، من طبيعة الإنسان وعادته ان لا يؤشر أو يترك على سند الدين بما يفيد براءة ذمة الدين إلا إذا كان الدين قد وفى دينه فيعتبر ذلك التأشير قرينة على الوفاء – إلا إذا اثبت الدائن العكس .
وكذلك، من طبيعة الإنسان وعادته ان لا يترك سند دينه للمدين إلا إذا اخذ دينه ، فإذا ما وجد سند الدين تحت يد المدين كان ذلك قرينة على تخلصه عن الدين إلا إذا اثبت المدين العكس .
فدفع قسط من الأجرة قرينة على دفع القسط السابق طبقا للمادة 587 من القانون المدني .
فقد اعتاد الناس على ان لا يعطى المؤجر مستأجر المسكن مثلا إيصالا باجرة شهر فبراير إلا إذا كان خالصا بأجرة الشهور السابقة .
المبرر الثاني : مراعاة الشارع للمصلحة العامة ، كقرينة قوة الشيء المحكوم به ، إذ تقضى المصلحة العامة باعتبار الحكم النهائي قرينة على صحة ما قضى به لإنهاء الخصومة ولمنع تجدد النزاع بلا حد ولا نهاية ، كما ان المصلحة العامة تقضى أيضا باحترام الأحكام القضائية النهائية .
المبرر الثالث : مراعاة الشارع للمصلحة خاصة أخذا بظواهر الأمور وتيسيرا لمعاملة الناس أو لتعذر التحقيق من أمر تعذر إثباته ، كحيازة المنقول ، فان الشارع اعتبرها قرينة على ملكيته – حسب ظاهر الحيازة .
فقد نصت المادة 976 من القانون المدني القائم على من جاز بسبب صحيح منقولا او حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله فانه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته
فإذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافر لدى الحائز فى اعتبار الشيء خاليا من التكاليف والقيود العينية فانه يكسب الملكية خالصة منها
والحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ، ونصت المادة 46 / 68 من القانون المدني السابق على ان:
ملكية الأموال المنقولة تنقل باستلامها بناء على سبب صحيح ولو لم تكن ملكا لمن سلمها بشرط ان يكون المستلم منعقدا صحة الملك فيها للمسلم .
ومعنى ذلك انك إذا اشتريت منقولا من شخص حائز له معتقدا ملكيته لهذا المنقول أصبحت مالكا له ولو لم يكن فى الواقع ملكا للبائع ، ولا يخفى أيضا انه من المتعذر بالتحقق من ملكية المنقول.
كما هي الحال في ملكية العقار بالكشف في السجلات .
ولذا تقررت قاعدة أن الحيازة في المنقول سند الملكية .
وكذلك، قرينة خطأ المتبوع او المخدوم عندما يخطئ التابع او الخادم قرينة قانونية على ان المتبوع او المخدوم قد اخطأ فى اختياره أو لم يحسن مراقبته .
المبرر الرابع : خوف الشارع من مخالفة الأحكام التي قررها والاحتيال عليها ، فمثلا للوصية أحكام خاصة إلا إذا أجازها الورثة.
فخوفا من الإيصاء فى شكل تصرف آخر اعتبر الشارع أن التصرف في مرض الموت المقصود به التبرع قرينة على انه وصية .
ولذلك أعطاه حكم الوصية ، وللورثة ان يثبتوا ان تصرف مورثهم كان فى مرض الموت بجميع طرق الإثبات.
ولا يحتج عليهم بتاريخ سند التصرف إلا إذا كان ثابتا قبل المرض .
وإذا اثبت الورثة ان التصرف صدر من مورثهم وهو في مرض الموت اعتبر التصرف صادر على سبيل التبرع .
ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك .
إذن، فالقرينة القانونية دليل ينقل عبء الإثبات من الواقعة الأصلية المراد إثباتها إلى واقعة أخرى قريبة منها ، وقد جعل المشرع من ثبوتها دليلاً على ثبوت الواقعة الأصلية .
ويعود ذلك إلى أن الواقعة الأخرى أيسر وأسهل في الإثبات من الواقعة الأصلية ، فالقرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات.
فلصاحب الشأن لا يكلف بإثبات الواقعة الأصلية ، وإنما يكلف بإثبات واقعة أخرى نص عليها القانون ، سهلة الإثبات ، لتكون قرينة قانونية على قيام الواقعة الأصلية المراد إثباتها .
وإذا كان من شأن القرينة القانونية ، إنها تنقل عبء الإثبات أو تغني نهائياً عن الإثبات .
في كلا الحالتين تورد استثناء على القاعدة العامة في الإثبات ، والاستثناء لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه.
وعلى ذلك فلا قرينة قانونية إلا بنص في القانون وما نص علية منها لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه .
أنواع القرائن القانونية
تنقسم القرائن القانونية إلى نوعين:
- النوع الأول هو القرائن القانونية البسيطة
- والنوع الثاني هو القرائن القانونية القاطعة .
- ولكل منهم أحكامه الخاصة .
النوع الأول : القرينة القانونية البسيطة كدليل
القرائن القانونية البسيطة هي قرائن تشريعية ، بمعني أن المشرع عليها قانوناً ، سواء في قانون الإثبات أو في أي قانون آخر.
وما يميزها أنه رغم النص عليها قانوناً فإنه يجوز إثبات عكسها .
ولعله ييسر فهم الأحكام الخاصة بالقرائن القانونية البسيطة أن نعدد أمثلة لها :
المثال الأول للقرينة القانونية البسيطة
ما تقضي به المادة 91 من القانون المدني ، والتي تنص على أن ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به .
ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
فيكفي في هذه الحالة إثبات واقعة وصول التعبير عن الإرادة إلى الطرق الأخر حتى تقوم قرينة العلم به ممن وجه إليه .
فينتقل عبء الإثبات إلى هذا الأخير .
المثال الثاني للقرينة القانونية البسيطة
ما نصت عليه المادة 11 من قانون الإثبات التي تفترض أن ما دون في الورقة الرسمية من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره مطابق للواقع .
ما لم يتبين تزويره بالطرق المقرر قانوناً في هذا الشأن .
المثال الثالث للقرينة القانونية البسيطة
ما نصت عليه المادة 817 من القانون المدني من أن الحائط الذي يكون وقت إنشائه فاصلاً بين بناءين يعد مشتركاً حتى مفرقها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المثال الرابع للقرينة القانونية البسيطة
ما نصت عليه المادة 964 من القانون المدني من أن من كان حائزاً للحق اعتبر صاحبة حتى يقوم الدليل على العكس . فيكفي إثبات واقعة الحيازة ، حتى تقوم قرينة واقعة ثبوت الملكية .
فلا يكلف الحائز بإثبات الملكية ، بل ينقل عبء الإثبات إلى خصمه .
المثال الخامس للقرينة القانونية البسيطة
ما تنص عليه المادة 587 من القانون المدني من أن الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .
فيكفي أن يثبت المستأجر أنه وفى بأجرة الشهر الأخير حتى يقيم قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة عليه ،عندئذ ينتقل عبء إثبات العكس إلى المؤجر .
المثال السادس للقرينة القانونية البسيطة
كذلك ما تنص عليه المادة 976 فقرة 2 من القانون المدني التي تجعل الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ، حتى يقوم الدليل على إثبات عكس ذلك .
ضحد القرائن القانونية البسيطة بإثبات عكسها
قلنا أن ما يميز القرائن القانونية البسيطة هو أنه يجوز إثبات عكسها ، ومتي ثبت عكسها سقطت كدليل ، فالوفاء بقسط لاحق من الأجرة .
وإن كان قرينة قانونية بسيطة على الوفاء بالقسط السابق ، إلا أنه يجوز للمؤجر إثبات عدم الوفاء بالأقساط السابقة بكافة طرق الإثبات .
النوع الثاني : القرينة القانونية القاطعة
القرائن القانونية القاطعة هي النوع الثاني من القرائن القانونية ، وهي الأهم ، وهي كذلك قرائن نص المشرع عليها ، أي نص في قانوناً .
سواء في قانون الإثبات أو في أي قانون آخر ، وما يميزها ندرتها و أنه لا يجوز إثبات عكسها إلا إذا وجد نص يحول دون إثبات عكسها .
وفي ذلك تنص المادة 99 من قانون الإثبات:
القرينة القانونية تغني من قررت لمصلحته عن أيـة طريقة أخرى من طرق الإثبات .
على أنه يجوز أن تقضي هذه القرينة بالدليل العكسي ، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .
ولعله ييسر فهم الأحكام الخاصة بالقرائن القانونية القاطعة أن نعدد أمثالاً لها :
المثال الأول للقرينة القانونية القاطعة
ما نصت عليه المادة 378 من القانون المدني من أن مرور سنة كاملة على استحقاق التجار والصناع والفنادق والمطاعم والخدم لأجورهم دون مطالبة قضائية بها ، قرينة على الوفاء بها من جانب المدين ، وهي قرينة لا تقبل إثبات العكس .
المثال الثاني للقرينة القانونية القاطعة
ما نصت عليه المادة 374 من القانون المدني والتي تنص على تقادم الالتزامات بوجه عام بانقضاء خمس عشرة سنة . فهذه قرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس .
المثال الثالث للقرينة القانونية القاطعة
ما نصت عليه المادة 375 من القانون المدني والتي تنص على تقادم الالتزامات الدورية المتجددة بانقضاء خمس سنوات .
المثال الرابع للقرينة القانونية القاطعة
ما تنص عليه المادة 968 من القانون المدني التي تقرر كسب الملكية بالتقادم الطويل .
تكييف القرينة القانونية
ما هو معيار التمييز بين القرائن القانونية القاطعة والقرائن القانونية البسيطة؟
انتهينا في السطور السابقة أن القرينة القانونية البسيطة يجوز إثبات عكسها ، أما القرينة القانونية القاطعة فإن كان يجوز إثبات عكسها .
إلا أن المشرع في بعض الحالات يقرر حمايتها مطلقاً فلا يجوز إثبات عكسها ، والأمثلة السابقة للقرائن القانونية القاطعة توضح ذلك .
وتكييف القرائن القانونية ، قرينة قانونية بسيطة أم قرينــة قانونية قاطعة ، بما يترتب عليه تحديد نوعها .
ومن ثم تحديد النظام القانوني الذي تخضع له بالأدق جواز إثبات عكسها من مسائل القانون .
مما يخضع المحكمة لرقابة محكمة النقض .
قضت محكمة النقض
لقاضى الموضوع التعرف على حقيقة العقد والتحري عن قصد المتصرف من تصرفه فى ضوء ظروف الدعاوى مادام قد برر قوله فى ذلك بما يحمله ويؤدى إليه .
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار ان العقد موضوع النزاع يخفى وصية بعد ان استظهر فى أسباب سائغة قيام الشرطين اللذين تستلزمهما القرينة القانونية المستفادة من نص المادة 917 من القانون المدني .
وانتهى إلى ان التصرف موضوع النزاع ساتر لوصية مرتكنا فى ذلك إلي ما اطمأن اليه من أقوال الشهود واى قرائن أخري باعتبارها أدلة متساندة تؤدى فى مجموعها الى ما انتهى اليه من ان العقد يخفى وصية .
فان مؤدى ذلك من الحكم عدم تنجيز التصرف .
كما قضت محكمة النقض
إذا كان الحكم المطعون فيه نفى بأسباب احتفاظ المورث بحيازته للعين المتصرف فيها – واعتبر قيامه بتحصيل أجرتها بعد التصرف فيها إنما كان لحساب أولاده القصر – المتصرف إليهم – بصفته وليا طبيعيا عليهم .
ولم يكن لحساب نفسه لعدم استناده فى ذلك إلى مركز قانوني يخوله حق الانتفاع بتلك العين فان الحكم المطعون فيه ، وقد قضى باعتبار البيع منجزا مستوفيا أركانه القانونية ومنها الثمن .
وانه صدر من المورث فى حال صحته ولا يقصد به الوصية مستندا فى ذلك إلي أسباب سائغة تكفى لحمل قضائه ولا فساد فيها.
فان النعي عليه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال يكون على غير أساس .
كيف تهدم القرائن القانونية البسيطة والقاطعة؟
القرائن القانونية بنوعيها ، البسيطة و القاطعة ، تبين كيف تثبت واقعة ما . ويترتب على ذلك أنه رغم قيام القرينة القانونية فإنه يجوز دائماً هدمها بالإقرار واليمين .
سواء أكانت القرينة القانونية بسيطة أم قاطعة ، فعلى الرغم من أنه لا يجوز إثبات العكس في القرائن القانونية القاطعة إلا أنه إذا قدم الخصم إقرار من الخصم الأخر صادر لصالحة فإنه يهدم القرينة القانونية القاطعة .
أو أن يوجه إليه اليمين القانونية فينكل عنهـا ، فهنا تنهدم القرينة القانونية على الرغم من كونها قرينة قانونية قاطعة.
مثال ذلك، ما نصت عليه المادة 378 من القانون المدني من قيام قرينة قانونية قاطعة وهي قرينة الوفاء بالأجر ولصالح المدين .
فإذا قدم الدائن إقراراً من مدينة يفيد عدم وفائه بالأجر.
أو وجه إليه اليمين بأنه قام بالوفاء فنكل عنها ، انهدمت القرينة.
وأصبح المدين ملزماً بالوفاء ، رغم مرور سنة على الدين دون مطالبة .
القرائن القضائية كدليل اثبات
القرائن القضائية هي النوع الثاني من القرائن .
ويمكن تعريف القرائن القضائية بأنها استنتاج صحة واقعة لم يرد عليها دليل من ثبوت واقعة أخري ثبتت بدليل .
وتوصف بأنها قضائية لأن القاضي هو الذي يستنتجها .
وقد يسعى إلى عملية الاستنتاج أحد خصوم الدعوى ومتي أقرها القاضي كانت قضائية
وعن الأساس القانوني يجري نص المادة 100 من قانون الإثبات
يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود .
مقدمات التعامل مع القرائن القضائية كدليل
يبين من هذا نص المادة 100 من قانون الإثبات ان المشرع جعل الإثبات بالقرائن القضائية مقصورا على الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود.
فيكلف الخصم الذي يقع عليه الإثبات أن يقدم للقاضى الإمارات أو العلامات التي يستخلصها من ظروف الدعوى ليستدل بها على صحة ادعائه .
ومن واجب القاضي أن يفحص هذه العلامات والإمارات للتحقق من صحتها وملابساتها ومن هذا يتضح لنا أن القرينة القضائية تقوم على عنصرين :-
- العنصر الأول للقرينة القضائية : وهو عنصر مادي ويقوم على اختيار الوقائع الثابتة من ظروف الدعوى والأوراق المقدمة فيها .
- العنصر الثاني للقرينة القضائية : وهو عنصر معنوي ويتمثل فى فحص هذه الوقائع ليستنبط منها القاضى القرينة التي يستدل بها على صحة الواقعة مصدر الحق المدعى به .
ولازم ذلك انه يتعين على القاضى ألا يأخذ بالقرائن القضائية إلا مع الحرص الشديد واليقظة التامة فلا يستمد قرينة إلا من الوقائع الثابتة فى الدعوى ولا يتخذها دليلاً إلا بعهد الاقتناع سلامتها.
وإلا كان حكمه مشوبا بالقصور .
مصدر القرائن القضائية
أوضحنا فيما سلف أن مصدر القرائن القانونية سواء القرائن القانونية القاطعة أو البسيطة هو النص التشريعي.
وهو سند تسميتها بالقرائن القانونية .
أما القرائن القضائية فمصدرها عمليات استنتاج عقلية ومنطقية يجريها القاضي – محكمة الموضوع.
فيختار الواقعة أو الإمارة التي تعد لديه معلومة ثابتة .
ويجري كما ذكرنا عمليات استنتاج لوقائع أخري مطلوب إثباتها .
هل من قيود علي حرية محكمة الموضوع في اختيار مصدر القرينة القضائية؟
ثمة قيود تفرض علي حرية القاضي وهو يتولي القيام بعملية الاستنتاج نتعرض لها بشكل علمي فنسميها قيود مصدر القرينة :
- القيد الأول : وحاصل هذا القيد أن تكون الواقعة مصدر الاستنتاج والتي يختارها القاضي ثابتة بيقين من ظروف الدعوى أو الأوراق المقدمة فيها ، فلا يمكن القبول باستنتاج من واقعة غير ثابتة أو مشكوك في صحتها .
- القيد الثاني : وحاصل هذا القيد ان يكون ما استخلصه القاضي من الواقعة الثابتة يقيناً من ظروف الدعوى أو المستندات المقدمة فيها يؤدى عقلا إلى إثبات الأمر المدعى به ،.
ولا يهم من بعد ذلك طبيعة مصدر القرينة أساس الاستنتاج ، المهم أن تكون هذه الواقعة مشروعة في ذاتها وأن يكون مصدرها – كأساس – الدعوى .
ولذا
- يجوز لمحكمة الموضوع أن تستخلص القرينة القضائية من مناقشات الخصوم .
- يجوز لمحكمة الموضوع أن تستخلص القرينة القضائية من شهود أحد الخصوم الذين سمعوا في الدعوى المنظورة .
- يجوز لمحكمة الموضوع أن تستخلص القرينة القضائية من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى المنظورة .
- يجوز لمحكمة الموضوع أن تستخلص القرينة القضائية من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير بغير حلف يمين .
- يجوز للقاضى ان يستخلص القرينة القضائية من أي محرر أو مستند مقدم الدعوى حتى ولو لم يكن الخصم طرفا فيه .
- يجوز للقاضى أن يستخلص القرينة القضائية من تصرف قانوني حتى ولو كان باطلاً .
- يجوز لمحكمة الموضوع أن تستخلص القرينة القضائية من امتناع الخصم عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة من إجراءات الإثبات .
- يجوز لمحكمة الموضوع ان تستخلص القرينة القضائية من امتناع الخصم عن الحضور فى الجلسة المحددة للاستجواب .
- يجوز لمحكمة الموضوع ان تستخلص القرينة القضائية من امتناع الخصم عن الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه فى الجلسة .
- يجوز لمحكمة الموضوع ان تستخلص القرينة القضائية من نكوله عن حلف اليمين .
قضى محكمة النقض في هذا الصدد
محاضر جمع الاستدلالات التي تقدم صورها الرسمية في الدعاوى المدنية لا يتعد وأن تكون مستنداً من مستندات الدعوى.
من حق المحكمة أن تستخلص منها مما تتضمنه من استجوابات ومعاينات مجرد قرينة تستهدي بها للتوصل إلى وجه الحق في الدعوى المعروضة عليها .
فلها أن تأخذ بها ، ولها أن تهدرها ، ولها أن تنفي جزءاً منها وتطرح سائرة دون أن يكون لها تأثير في قضائها .
هل يجوز أن يكون مصدر القرينة القضائية وقائع خارج الدعوى المتداولة ؟
ليس ثمة ما يمنع من استنباط القرينة القضائية من وقائع خارج الدعوى ولكن يشترط لذلك أن تكون الأوراق الخاصة بهذه الوقائع مقدمة ضمن مستندات الدعوى حتى يستطيع الخصم الذي يحتج عليه بالقرينة فرصة مناقشتها ودحضها .
بمعني أكثر دقة يجب ألا يتعارض حق محكمة الموضوع في اختيار مصدر القرينة القضائية مع مبدأ حق كل خصم في مواجهته بما قد يعد أساساً للفصل في الدعوى والرد عليه .
والحق في المواجهة حق دستوري .
حدود سلطة محكمة الموضوع فى استنباط القرائن القضائية
ما هي حدود سلطة محكمة الموضوع فى استنباط القرينة القضائية؟
إذا كان قاضى الموضوع حرا فى اختيار أية واقعة من الوقائع الثابتة فى الدعوى ليستنبط منها القرينة القضائية فهو حر أيضا فى تقدير ما تحمله هذه الواقعة من الدلالة .
ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كانت القرينة التي استخلصها مستمدة فى واقعة ثابتة يقينا وكان استنباطه مقبولا عقلا .
وينبني على هذا انه إذا كان القاضى قد استمد قرينته من واقعة محتملة أو غير مقطوع بها أو من واقعة لا وجود لها فعلاً أو كان قد استمد القرينة من واقعة ثابتة .
ولكن استخلاصه غير مقبول عقلا أو يتعارض مع الثابت فى الأوراق فان حكمه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
تجاوز حدود و نطاق الإثبات بالقرائن القضائية
لما كان الإثبات بالقرائن القضائية – القرائن القضائية كدليل – يقوم على الترجيح والاستنباط ، وهما عمليتان عقليتان ، مما قد يعني اختلاف الحكم بالقرينة الواحدة من قاض لآخر علي ذات القرينة .
فيرها أولهم كفايتها ، ويراها الثاني غير ذلك ، والقضاة جميعا كحقيقة ليسوا على مستوى واحد من الفطنة والذكاء ، كما أنهم غير معصومين من الخطأ والزلل .
لذا جعل مشرع قانون الإثبات نطاق الإثبات بالقرائن القضائية محددا في دائرة الإثبات بشهادة الشهود فلم يجز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالبينة .
فما يمكن إثباته بالبينة يمكن إثباته بالقرائن والعكس صحيح .
ولمعرفة موقع القرائن ضمن منظومة الإثبات الحر والمقيد، راجع: هل للحق قيمة دون دليل؟ (الإثبات الحر والمقيد) .
نتائج سريان الأحكام الخاصة بالإثبات بشهادة الشهود علي الإثبات بالقرائن القضائية
طبقاً لنص المادة 100 من قانون الإثبات :
يترك لتقدير القاضى استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود .
ويتفرع على هذا ان جميع القواعد الخاصة بشهادة الشهود تسرى على القرائن القضائية بغير استثناء فلا يقبل الإثبات بهذه القرائن إلا فى الحالات التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة .
وينبني على هذا انه يجوز إثبات التصرفات المدنية التي لا تزيد قيمتها على مائه جنيه بالقرائن وكذلك المسائل التجارية التي لا يشترط فيها القانون الكتابة ، وكافة الوقائع المادية .
وإذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة جاز تكمله دلالته بالقرائن دون شهادة الشهود .
كما انه إذا قام مانع أدبي يحول دون الإثبات الكتابة جاز إثبات التصرف المدعى به بالقرائن أيا كانت قيمته .
وكذلك يصح إثبات التصرف القانوني بالقرائن إذا كان السند المثبت له قد ضاع من صاحبه بسبب أجنبي .
وإذا كانت جميع القواعد الموضوعية الخاصة بشهادة الشهود تسرى على القرائن القضائية فان مقتضى هذا انه إذا أدلى الخصم بقرينة قضائية ليستدل بها على صحة ادعائه .
فمن حق الخصم الأخر يدحض مزاعم خصمه بالقرائن ، و القاضي حر فى النهاية في تقدير القرائن القضائية التي أدي بها كل من الطرفين ، فله ان يأخذ بالقرائن التي يقتنع بها ويرتب عليها حكمه فى الدعوى .
وغنى عن البيان انـه يجوز للقاضى ان يرفض طلب الإثبات بشهادة الشهود إذا توافرت فى الدعوى القرائن القضائيـة التي تكفى لتكوين عقيدته و إقامة حكمه عليها .
بناء الحكم علي قرينة قضائية أو عدة قرائن
اعترف المشرع بالقرائن القضائية كدليل ، وأنزلها منزلة شهادة الشهود ، ويترتب علي ذلك عدة نتائج هامة في مجال التعامل مع القرائن كدليل :
- النتيجة الأولي : يكفي أن يبني الحكم علي قرينة قضائية صحيحة ، فلا يشترط ان يبنى القاضى حكمه على عدة قرائن.
مرد ذلك أنه يجوز للقاضى ان يبنى حكمه على شهادة شخص واحد متى كان قد اطمأن إلي صدق شهادته .
فيصح بالتالي علي سند من وحدة قوة الدليل أن يبنى حكمه على قرينة واحدة متى كانت قوية ومنتجة فى الإثبات .
- النتيجة الثانية : في حالة تعدد القرائن القضائية في الحكم القضائي الواحد.
يجب أن تكون هذه القرائن منسجمة مع بعضها البعض ليس بينها تعارض في مستوي القبول العقلي الذي يستعصي علي قبول المتناقضات .
مشكلات تعارض تعدد القرائن القضائية
يقول الدكتور عبد الحكم فوده :
إذا أقام القاضي حكمه على عدة قرائن فان الحال لا يخرج عن أحد الأمور الثلاثة الآتية :-
أولا : إذا كان الحكم قد بنى على عدة قرائن متساندة يكمل بعضها بعضا ، ففي هذه الحالة تعتبر هذه القرائن وحدة غير قابلة للتجزئة .
ولا يقبل من الخصوم مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها بذاتها متى كانت هذه القرائن مستنبطة من أوراق الدعوى وظروفها وتؤدى فى مجموعها إلي النتيجة التي انتهى إليها الحكم .
ثانياً : أن يكون الحكم قد أقيم على أكثر من قرينة وحدد فى أسبابه دلالة كل واحدة منها فإذا ظهر فساد بعض هذه القرائن فلا يصح تعيب الحكم متى كانت إحدى القرائن الأخرى صحيحة وتكفى لحمله .
ثالثاً : أن يكون الحكم قد أقيم على جملة قرائن مجتمعة دون ان يبين القاضى فى أسباب الحكم اثر كل قرينة على حدة فى تكوين عقيدته.
ثم ظهر فساد بعضها بان كانت إحداهما غير مستساغة عقلا أو مخالفة للثابت من الأوراق او مستمدة من واقعة لا وجود لها.
وكان لا يمكن ان يعرف ماذا كان قضاؤه يكون بعد إسقاط القرينة الفاسدة من التقدير .
فان حكمه يكون قد عاره بطلان جوهري لقصور أسبابه مما يستوجب نقضه .
وإذا استدل الخصم بقرائن قضائية لإثبات ادعائه فان من حق الخصم الآخر مناقشتها ودحضها بكافة طرق الإثبات .
فإذا لم تمكنه المحكمة من ذلك او لم تعن بالرد على دفاعه فى هذا الخصوص فان حكمها يكون مشوبا بالقصور ، ولقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير قيمة القرائن التي يستدل بها الخصم على تأييد ادعائه.
فللمحكمة أن تأخذ بها او تطرحها إذا تراءى لها انه لا حاجة لها بها وليس القاضي ملزما أن يبين سبب عدم الأخذ بها متى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم تؤدى إلي ما انتهى إليه.
وتحمل الرد الضمني على أنها اطلعت على هذه القرائن أخضعتها لتقديرها ولم تر الأخذ بها أما إذا استبان من تقريرات الحكم أن المحكمة لم تطلع على القرائن التي أدلى بها الخصم .
وبالتالي، لم تبحثها وكانت هذه القرائن منتجة في الإثبات بحيث لو عرضت لها المحكمة وبحثها لكان قد تغير وجه الرأي في الدعوى فان حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه .
مصدر البجث القانوني
الدكتور عبد الحكم فوده – قانون الاثبات.
فى الختام، تعرفنا أن القرائن كدليل غير مباشر، ومباشر و طريق لاثبات الواقعة القانونية، فى الدغاوي المدني، سواء كانت قرائن قضائية، او قرينة قانونية، وكل قرينة لها أنواع وقوة في الاثبات تختلف عن الأخري.
للاستشارة القانونية وحجز موعد
إذا كنت تحتاج تقييمًا قانونيًا متخصصًا أو ترغب في حجز موعد بالمكتب، يمكنك التواصل عبر الوسائل التالية:
اتصل بنا عبر صفحة التواصل:
لحجز موعد بالمكتب:
تاريخ النشر: 2024-12-26
- استرداد قيمة شيكات الضمان: كيف رجعنا 484,960 جنيه؟ (04/01/2026)
- استمرار شركة التضامن بعد وفاة الشريك: ما الشروط؟ (04/01/2026)
- شرح كتاب الشرط الصريح الفاسخ للدكتور محمد حسين منصور (03/01/2026)
- فسخ الإيجار للشرط الفاسخ وتأخر الأجرة: تحليل حكم 2025 (02/01/2026)
- تقرير إنجازات عبدالعزيز حسين عمار 2025: ريادة قانونية رقمية (31/12/2025)
- حجية الأحكام: متى لا يحاج المشتري بحكم صورية ضد بائعه؟ (30/12/2025)
للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا — هاتف: 01285743047 — واتساب: 01228890370
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2024/12/القرائن-كدليل-مباشر-اثبات-واقعة-قانون.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2024-12-26.