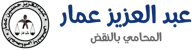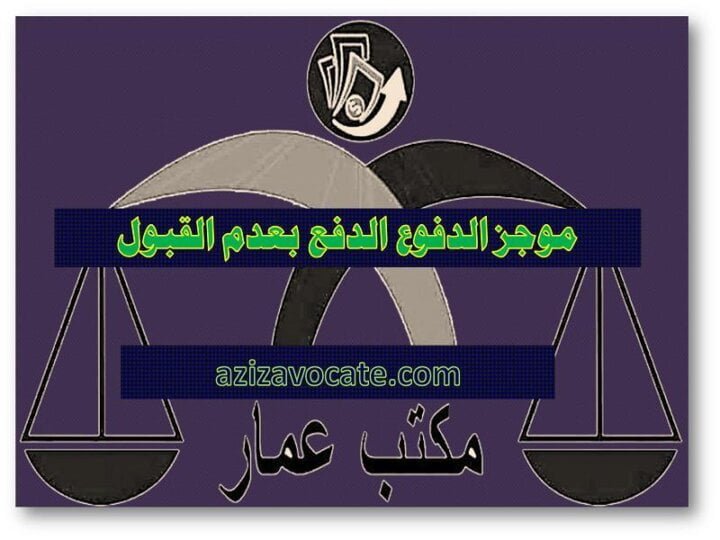دراسة شاملة لمعنى الغش والبطلان الإجرائي في قانون المرافعات والاثار القانونية المترتبة علي ذلك ، مع أمثلة عملية لحالات البطلان المتعلق بالنظام العام ( المطلق ) و البطلان الغير متعلق بالنظام العام ( النسبى ) ، كذلك تتناول تصحيح الاجراء الباطل والانتقاص منه ، كل ما تقدم وأكثر داخل مباحث الدراسة على ضوء أحكام محكمة النقض وأراء فقهاء قانون المرافعات.
الغش والبطلان في قانون المرافعات
تعريف قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية
قانون المرافعات ينظم سير القضايا أمام المحاكم، ويحدد الإجراءات التي يتبعها أطراف النزاع خلال مراحل التقاضي. لذا اذا طال اجراء من اجراء التقاضي البطلان ، فانه يؤثر بشكل مباشر على سلامة الإجراءات القانونية وبالتبيعية يؤثر على نتائج القضايا المدنية .
تعريف الغش في قانون المرافعات
هو أي فعل أو تصرف يُقدم به طرف من أطراف النزاع معلومات خاطئة أو مُضلّلة لخداع القاضي أو المحكمة، وذلك بهدف التأثير على قرار القضية لصالحه.
تعريف البطلان في قانون المرافعات
هو انعدام الصلاحية القانونية لعمل أو إجراء ما. ويكون العمل أو الإجراء باطلا لعدة أسباب، منها الغش، أو عدم مراعاة الشروط القانونية الأساسية لصحته التى نص عليها قانون المرافعات صراحة أو ضمنا ، أو وجود عيب جسيم يجعله غير صالح.
وينقسم البطلان في قانون المرافعات المصرى الى نوعين:
- البطلان المطلق: هو البطلان الذي لا يُمكن تصحيحه أو التغاضي عنه، مثل البطلان لعدم مراعاة الشروط القانونية. للإجراء.
- البطلان النسبي: هو البطلان الذي يُمكن تصحيحه أو التغاضي عنه بشرط طلب ذلك من طرف من أطراف النزاع و تقديم الأدلة اللازمة.
تعريف العمل الإجرائي فى قانون المرافعات
العمل الإجرائي هو العمل القانوني الذي يرتب عليه القانون أثرا إجرائيا ، أى أثرا في إنشاء الخصومة أو سيرها أو تعديلها أو انقضائها فيشترط في العمل لاعتباره عملا إجرائيا توافر ثلاثة شروط :
- أولها : أن يكون عملا قانونيا أى عملا تترتب عليه آثار قانونية فيخرج منه الأعمال التي تكون مقدمة لأعمال قانونية ولكنها ليست كذلك كدراسة القاضي للقضية وترتيب الكاتب لها في جدول الجلسة ،
- ثانيها : أن يرتب عليه القانون أثرا إجرائيا مباشرا يؤثر في بدء الخصومة أو سيرها أو تعديلها أو إنهائها فإذا لم يكن كذلك لم يعتبر عملا إجرائيا ولو كان عملا قانونيا كقرار القاضي نظر الدعوى قبل دورها
(نقض جنائي 29/1/1940 – م ق ج – 180 – 115)
ولو كان يرتب أثرا إجرائيا بطريق غير مباشر كالنزول عن الحق أو النزول عن الدعوى .
(والي في نظرية البطلان بند 30)
- ثالثها : أن يكون جزءا من الخصومة التي يراد اعتباره عملا إجرائيا بالنسبة لها.
(قارن فتحي سرور في نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية)
فلا يعد عملا إجرائيا متى تم خارج نطاق هذه الخصومة ولو كان يقصد تقدمه فيها كطلب إحدى الوثائق من إحدى الهيئات الإدارية لتقديمه في الخصومة إلا أنه لا يشترط أن يتم أمام مجلس القضاء فقبول الحكم يعتبر عملا إجرائيا رغم وقوعه خارج مجلس القضاء .
(محمد كمال عبد العزيز)
ويكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء . (مادة 20 مرافعات)
فالبطلان في قانون المرافعات هو أحد الجزاءات الإجرائية ذات النطاق العام الذي يصيب العمل الإجرائي الذي لا يتطابق مع نموذجية القانون، فالبطلان هو وصف قانوني لعمل إجرائي ينقصه شرط من شروط صحته ، وبالتالي ينصب البطلان على ذات العمل الإجرائي .
(عبد الحميد الشواربي)
ويمر البطلان بمرحلتين أولاهما قيام سبب البطلان وثانيهما هى تقرير القضاء له ، ولا تترتب آثار البطلان إلا بعد صدور هذا القرار الذي قد يمتنع إذا ما قام سبب من أسباب تصحيح البطلان رقم قيام موجبه .
الغش والبطلان شروطه في قانون المرافعات
واضح من نص الفقرة الأولى أن القانون الجديد يشترط لقيام موجب البطلان توافر شرطين :
- أولهما : وقوع عيب في أحد العناصر الشكلية للعمل الإجرائي أى أن يعيب هذا العمل عيب شكلي ، ويكون ذلك بمخالفة العمل الإجرائي للنموذج الشكلي الذي حدده له القانون ، فإذا لم تقع مخالفة للشكل القانوني امتنع الحكم بالبطلان ولو لم تتحقق من هذا الشكل الغاية التي يستهدفها منه القانون .
بل ولو أدى الى إتباع هذا الشكل الى الإضرار بالخصم ، ويقع عبء إثبات تعيب الشكل على من يدعيه اتباعا للقاعدة السابق الإشارة إليها من أن الأصل في العمل الإجرائي أنه قد استوفى عناصره الشكلية ، على أن من يدعى تعيب العمل الإجرائي قد يفيده في إثبات ادعائه أن القانون يتطلب بيان إتباع الشكل في المحرر المثبت للعمل الإجرائي ، إذ يقوم إغفال هذا البيان دليلا على عدم إتباع الشكل المطلوب .
- ثانيهما : أن يترتب على هذا العيب تخلف الغاية من العمل الإجرائي الذي لحقه العيب ، وفي هذا الصدد يتعين التفرقة بين البطلان المنصوص عليه والبطلان غير المنصوص عليه .
(محمد كمال عبد العزيز )
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 13 سنة 1968 :
كان مشروع الحكومة يورد في هذه المادة فقرة ثالثة تنص على أن ” وفي جميع الأحوال يجب الحكم بالبطلان إذا كان متعلقا بالنظام العام ، وقد حذفتها اللجنة التشريعية بمجلس الأمة حتى يسري حكم الفقرتين الأولى والثانية ولو تعلق البطلان بالنظام العام ولذلك فقد استبعدنا من المذكرة الإيضاحية ما يتعلق بهذه الفقرة .
كما أن مشروع الحكومة كان يستبدل قي الفقرة الثانية عبارة (من الشكل أو البيان المطلوب) وعبارة (من الإجراء) وقد استبدلت اللجنة العبارة الأخيرة بالعبارة الأولى توحيدا للاصطلاحات بتقدير أن تحقق الغاية من الإجراء تقتضي تحقق الغاية من الشكل أو البيان ولذلك أبقينا المذكرة الإيضاحية على حالها في هذا الخصوص .
وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع عن هذه المادة :
حرص المشروع على تنظيم بطلان الإجراءات تنظيما يتفق مع أهميته العلمية وهى أهمية فطنت إليها بعض التشريعات الأجنبية الحديثة كمجموعة المرافعات الإيطالية التي صدرت في 28 أكتوبر سنة 1940 ، ولهذا خصص المشروع للبطلان خمس مواد من المادة 20 الى المادة 24 .
حالات البطلان الشكلية في قانون المرافعات
1- تتناول المادة 20 تنظيم حالات البطلان بسبب العيوب الشكلية التي تصيب الإجراءات ، وقد رأى المشروع التفرقة بين حالة البطلان الذي يقرره القانون بعابرة صريحة منه وحالة عدم النص عليه فإذا نص القانون على وجبة إتباع شكل معين أو أوجب أن تتضمن الورقة بيانا معينا وقرر البطلان صراحة جزاء على عدم احترامه ، فإن الإجراء يكون باطلا ، وليس على من تقرر الشكل لمصلحته من الخصوم إلا أن يثبت تحقق العيب باطلا .
وليس على من تقرر الشكل لمصلحته من الخصوم إلا أن يثبت تحقق العيب ويتمسك بالبطلان ، على أن المشروع قدر أن الشكل ليس سوى وسيلة تحقيق غاية معينة في الخصومة ، فالقانون عند ما يتطلب شكلا معينا فإنما يرمى الى تحقيق غاية تحققها توافر هذا الشكل أو البيان .
وإذا ثبت تحقيق الغاية رغم تحلف هذا الشكل أو البيان ، فإن من التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان ويقع على عاتق يحصل التمسك ضده بالبطلان عبء إثبات أن الشكل أو البيان رغم تخلفه قد حقق الغاية منه ، فإذا أثبت هذا فلا يحكم بالبطلان .
وبهذا عدل المشرع عما يفهم من القانون من القانون الحالي من أن البطلان المنصوص عليه إجباري يجب على القاضي الحكم به دائما ، وهو عدول يتجه به المشروع الى مسايرة التشريعات الحديثة التي بدأها المشرع في فرنسا بقانون 12 يناير سنة 1933 والمرسوم بقانون 30 أكتوبر سنة 1935 واشترط فيهما تحقق ضرر بالخصم للحكم بالبطلان رغم النص صراحة عليه .
وأيده المشرع الإيطالي سنة 1940 بصورة أعم بنصه في المادة 156 من مجموعة المرافعات الإيطالية على ألا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا حقق الإجراء الغاية منه ، وهذا الاتجاه الحديث في التشريعات أيدته بعض أحكام القضاء للمصري وبعض الفقه في مصر ، وهو اتجاه يتسق في مصر مع الأخذ بمبدأ نسبية الحقوق الذي يعني أن الحق ليس غاية في ذاته إنما هو وسيلة لتحقيق غاية معينة .
ولهذا فإنه إذا نص القانون على البطلان وتحقق عيب في الإجراء فنشأ عنه حق لشخص في التمسك بالبطلان فإن هذا الحق إنما يقصد بإعطائه لصاحبه ضمان تحقيق الغاية من القاعدة المخالفة ، فإذا تمسك صاحب الحق بالبطلان رغم الغاية من الشكل أو البيان المطلوب ، فإنه يعتبر استعمالا غير مشروع للحق ، لأنه لا يتمسك به بقصد تحقيق الغاية التي أعطى الحق من أجلها إذ الغاية قد تحقق .
وربط شكل الإجراءات بالغاية منه يؤدي الى جعل الشكل أداة نافعة في الخصومة وليس مجرد قالب كالشكليات التي كان يعرفها القانون الروماني في عهد دعاوى القانون .
وإذا كان الاتجاه الذي غلبه المشروع يؤدي الى إعطاء سلطة كبيرة للقاضي ، فإن هذه السلطة يقيدها أن تحديد الغاية من الشكل مسألة قانون وليست مسألة واقعة يستقل فيها بالتقدير ، هذا فضلا عن أن القضاء في مصر قد أثبت دائما أنه أهل للثقة التي تمنح له .
ثم أن الأخذ بالمذهب الذي يلزم القاضي بالحكم بالبطلان لمجرد النص عليه دون أى تقدير يؤدي أحيانا الى الأضرار بالعدالة ، ذلك أن القاعدة القانونية قاعدة عامة بطبيعتها وعندما ينص القانون على البطلان في حالة معينة فإنه يراعى ما يحدث في الظروف العادية ، ولكن من الناحية العلمية إذا تحققت الغاية من الشكل في قضية معينة ، فإن البطلان يصبح لا ضرورة له ، بل ينتهي الى أن يكون سلاحا في يد سئ النية من الخصوم الذي يريد عرقلة الخصومة .
على أن المشروع لم ينشأ في تغليبه هذا الاتجاه أن ينحو الى المدى الذي ذهبت إليه بعض التشريعات كالمجموعة الإيطالية ، والتي تجعل من مجرد تحقق الغاية من الإجراء سببا لعدم الحكم بالبطلان ولو لم تحقق الغاية من الشكل أو البيان المطلوب بذلك أن هناك أشكالا للعمل أو بيانات في الورقة قد ترمى الى تحقق ضمانات معينة للخصومة لا تتصل اتصالا مباشرا بالغاية من الإجراء ، وإذا نص القانون على البطلان وتخلف الشكل أو البيان ولم تتحقق الغاية منه فيجب الحكم بالبطلان ولو تحقق الغاية من الإجراء .
ولم يقتصر المشروع على البطلان – شأنه شأن القانون الحالي – على حالات النص عليه ، فنص على أن الإجراء يكون باطلا إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء .
ويقصد المشروع بحالات عدم النص على البطلان ، عدم النص الصريح عليه فإذا نص القانون على أنه ” لا يجوز أو لا يجب ” ، أو نص على أية عبارة ناهية أو نافية فإنه بهذا لم يصرح بالبطلان ولا يحكم به إلا إذا وجد عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء والأصل في حالة عدم النص على البطلان أن الإجراء لا يبطل إلا إذا أثبت المتمسك بالبطلات فضلا عن العيب الذي شاب الإجراء أن هذا العيب قد أدى إلى عدم تحقق الغاية من الإجراء فعبء إثبات عدم تحقق الغاية يقع على عاتق المتمسك بالبطلان ولا يكفيه إثبات عدم تحقق الغاية من الشكل أو البيان.
وإنما يجب عليه إثبات عدم تحقق الغاية من الإجراء ، ذلك أن القانون مادام ينص على البطلان جزاء لشكل أو بيان معين فإنه يدل بهذا على عدم إرادته توافر هذا الشكل أو البيان إلا بالقدر اللازم لتحيق الغاية من العمل الإجرائي الذي يتضمنه ، وينظر القاضي إلى الغاية الموضوعية من الإجراء ، وإلى تحققها في كل قضية على حدة ، وهذا التحديد من المشروع هو الذي أخذت به مجموعة المرافعات الإيطالية للإجراءات الجوهرية في المادة 156 منها .
ويتضح مما سبق أن المشروع قد اعتد في تنظيمه للبطلان تارة بالغاية من الإجراء وتارة بالغاية من الشكل أو البيان .
وكل عمل إجرائي باعتباره عملا قانونيا يجب أن تتوافر فيه شروط معينة منها ما يتعلق بالمحل أو بشخص القائم بالعمل ومنها ما يتعلق بشكل العمل .
وللشكل أهمية كبيرة في قانون المرافعات ، وإذا كانت القاعدة في القانون المدني هى مبدأ حرية الشكل ، فإن القاعدة في قانون المرافعات هى على العكس قانونية الشكل ، بمعنى أن جميع أوجه النشاط التي تتم في الخصومة يجب كقاعدة عامة أن تتم لا تبعا للوسيلة التي يختارها من يقوم بها بل تبعا للوسيلة التي يحددها القانون .
والشكل في العمل الإجرائي قد يكون عنصرا من عناصره وقد يكون ظرفا يجب – وجوده خارج العمل لكى ينتج العمل آثاره القانونية .
والشكل كعنصر للعمل يتضمن وجوب تمام العمل كتابة ووجوب أن تتضمن الورقة بيانات معينة .
والشكل كظرف للعمل قد يتصل بمكان العمل كوجوب تسليم الإعلان في موطن المعلن إليه أو وجوب أن يتم الحجز في مكان المنقولات المحجوزة كما قد يتصل بزمان العمل وبالزمن كشكل للعمل قد يكون زمنا مجردا بغير نظر الى واقعة سابقة أو لاحقة كوجوب أن يتم الإعلان بين السابعة صباحا والخامسة مساء .
وقد يكون الزمن هو يوما معينا كوجوب إجراء المرافعة في أول جلسة وقد يتحدد الزمن بميعاد أى بفترة بين لحظتين : لحظة البدء ولحظة الانتهاء ، وقد يكون ميعادا يجب أن ينقضي قبل المكان القيام بالعمل ، وقد يكون ميعادا يجب أن يتم العمل قبل بدئه وقد يكون ميعادا يجب أن يتم العمل خلاله وأخيرا يدخل في عنصر الزمن أيضا ما ينص عليه القانون من ترتيب زمن معين بين الأعمال الإجرائية .
ومما تقدم يبدو وضوح أن الشكل ليس هو الإجراء ، ذلك أن الإجراء أو العمل الإجرائي هو عمل قانوني يجب أن تتوافر فيه شروط معينة من بينها الشكل الذي حدده القانون .
وقد رأى المشروع كما سبق بيانه أنه إذا نص القانون صراحة على البطلان فإن معيار الحكم بالبطلان من عدمه يكون بالنظر الى الشكل أو البيان في الإجراء – والبيان ليس سوى شكل من أشكال العمل – فلا يكفي لعدم الحكم بالبطلان مجرد إثبات تحقق الغاية من الشكل.
وتطبيقا لذلك إذ ينص المشروع على أنه يجب أن تضتمن ورقة المحضرين عدة بيانات كل بيان يرمى الى تحقيق غاية معينة (مادة 9 مشروع) وينص على البطلان صراحة جزاء لتخلف هذا البيانات (مادة 19) فإنه إذا أعلنت ورقة محضرين لم تشتمل مثلا على تاريخ اليوم والشهر والسن والساعة التي حصل فيها الإعلان واشتملن على البيانات الأخرى ووصل الإعلان الى المعلن إليه ، فلا ينظر الى الغرض من الإعلان وهو إيصال واقعة معينة الى علم المعلن إليه ، وإنما ينظر الى بيانات الورقة .
فإذا تبين أن التاريخ الذي حصل فيه الإعلان يؤدي وظيفة معينة في هذا النوع من الإعلان الذي حدث ، كما لو كان إعلانا يبدأ به ميعاد طعن ، فإن الإعلان يكون باطلا لعدم تحقق الغاية من بيان التاريخ أما إذا كان التاريخ ليس هذه الوظيفة في الإعلان الذي حدث كما لو كان إعلانا لا يجب تمامه في ميعاد معين ولا يبدأ به أى ميعاد ، فلا يحكم بالبطلان .
ومن ناحية أخرى إذا فرض ولم يشتمل الإعلان على بيان اسم المحضر فإنه لا يحكم بالبطلان إذا كان المحضر قد وقع على الإعلان ذلك أن الغرض من بيان المحضر هو التثبت من أن الإعلان قد تم على يد موظف مختص بإجرائه ويغني عنه إمضاء المحضر فإذا لم تشتمل الورقة على اسم المحضر ولا على إمضائه فإن الإعلان يكون باطلا ولو وصل الى المعلن إليه وتسلمه .
كذلك يعتبر البيان المتعلق باسم المعلن أو المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته مستوفيا مهما حدث النقص فيه مادام تحقق الغرض منه وهو تعيين شخصية المعلن أو المعلن إليه .
وتجدر الإشارة الى أنه لا محل لإعمال نظرية البطلان المنصوص عليها في هذه المادة والمواد التي تليها حيث ينص المشرع على جزاء آخر كسقوط الإجراء أو اعتباره كأن لم يكن أو عدم قبوله الى غير ذلك من أنواع الجزاءات ، بل يتعين عند نص المشرع على جزاء آخر خلاف البطلان التزام أحكام هذا الجزاء دون خلط بينها وبين أحكام البطلان.
راجع في التفرقة بين البطلان وبين عدم القبول والسقوط فتحي والي في نظرية البطلان بند 1 وأبو الوفا في المرافعات بند 413 وراجع في التفرقة بين البطلان واعتبار الخصومة كأن لم تكن أبو الوفا في المرافعات بند 409 وفي نظرية الدفوع بند 178، (محمد كمال عبد العزيز
وقد قضت محكمة النقض بأنه
إذ كان الدفع المبدى من الطاعن يعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمته المادة 63 من قانون المرافعات هو في حقيقته دفع بعدم قبولها لرفعها بغير هذا الطريق فإنه لا محل لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الغاية من الإجراء قد تحققت بطرح الدعوى على المحكمة بما يصحح الإجراء ولو كان تعييبه راجعا لأمر متعلق بالنظام العام .
إذ عدم استيفاء الدعوى لشروط رفعها جزاؤه عدم القبول وليس البطلان وتحقق الغاية من الإجراء – حسبما تنص على ذلك المادة 20 من قانون المرافعات – لا يكون إلا بصدد جزاء البطلان ولا يتعداه الى غير ذلك من الجزاءات . لما كان ما تقدم ، فإنه تتوافر للدفع مقومات قبوله وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفضه فإنه يكون قد خالف القانون.
(20/6/1979 طعن 1145 سنة 48ق – م نقض م – 30 العدد الثاني – 713 – 14/12/1983 طعن 1609 سنة 49ق – م نقض م – 34 – 1816)
ونلاحظ من نص المادة 20 أن المشرع أراد منعا من أى لبس ألا يقرر البطلان القانوني إلا بلفظه بحيث لم تعد العبارة الناهية أو النافية (لا يجوز مثلا) مؤدية في ذاتا لتقرير البطلان القانوني ، فالقاضي إذن لا يحكم بالبطلان على أساس أنه منصوص عليه في التشريع إلا إذا تقرر البطلان يلفظه أى يقول النص (وإلا كان الإجراء باطلا مثلا) ولا يعمل بهذه القاعدة المستحدثة إلا بالنسبة لقانون المرافعات الجديد والقوانين التالية عليه فقط .
أما القوانين السابقة عليه والتي تعتمد على تقرير البطلان بعبارة ناهية أو نافية إعمالا للمادة 25 من قانون المرافعات السابق – هذه القوانين يجب احترام حالات البطلان فيها ولو عبارة ناهية أو نافية .
وإذا نص القانون صراحة على البطلان وتمسك الخصم به وفقا للقانون ، فإن على المحكمة الحكم بالبطلان ما لم يتمسك خصمه بأنه على الرغم من حصول المخالفة الموجبة للحكم بالبطلان ، وعلى الرغم من عدم احترام ذات الشكل ، إلا أنه قد ثبت تحقق الغاية من الشكل – وعليه هو إثبات تحقق الغاية من الإجراء وفق الشكل المقرر في التشريع
(راجع تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الأمة عن المادة 20)
وتجب التفرقة بين الغاية من الإجراء والغاية من الشكل ، فقد تتحقق الغاية من الإجراء ومع ذلك يكون الإجراء باطلا لعدم تحقق الغاية من الشكل .
فالإعلان على يد محضر يحقق الغرض منه ولو تم في عطلة رسمية ، وإنما هو عندئذ لا يحقق الغاية من الشكل ، والحكم ولو لم يسبب يحقق الغاية منه – وهى حسم النزاع بين الخصوم – بينما الغاية من الشكل المقرر في التشريع لا تتحقق وهو ضمان جدية الحكم . فالغاية من الشكل هى الضمان الأساسي الجوهري المقرر لمصلحة الموجه إليه الإجراء ، وهى ما يهدف المشرع الى تحقيقه في القانون الإجرائي .
بينما الغاية من الإجراء هى ما يهدف مباشر الإجراء الى تحقيقها ، وشتان بين الغرضين والهدفين ، لأن الغاية الأخيرة قد تتحقق بدون أى شكل أوب شكل معدوم ، بينما الغاية من شكل الإجراء لا تتحقق إلا بشكل صحيح وأن لم يكن هو ذات الشكل المطلوب .
( أبو الوفا )
البطلان غير المنصوص عليه فى قانون المرافعات
فإنه لا يكفي لمن يتمسك بقيان موجب البطلان أن يثبت تعيب شكل العمل الإجرائي بل عليه أن يثبت فوق ذلك توافر أمرين آخرين أولهما الغاية من العمل الإجرائي وثانيهما قيام رابطة سببية بين العيب الذي أثبت أنه شاب العمل وبين تخلف الغاية منه .
وقد قضت محكمة النقض بأنه
النص في المادة 20 من قانون المرافعات على أنه: يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لن تتحقق بسببه الغاية من الإجراء – ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ” يدل – وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية في خصوص هذه المادة – أن المشرع قرر التفرقة بين حالة البطلان الذي يقرره القانون بعبارة صحيحة منه وحالة عدم النص عليه .
فإذا نص القانون على وجوب إتباع شكل معين أو أوجب أن تتضمن الورقة بيانا معينا وقرر البطلان صراحة لجزاء على عدم احترامه ، فإن الإجراء يكون باطلا – وليس على من تقرر الشكل لمصلحته من الخصوم إلا أن يثبت تحقيق غاية معينة في الخصومة ، فالقانون عندما يتطلب شكلا معينا أو بيانا معينا قائما يرمى إلى تحقيق غاية يحققها توافر هذا الشكل أو البيان .
فإن من بين التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان ومؤدى ذلك أن ربط شكل الإجراء بالغاية منه إنما يستهدف جعل الشكل أداة نافعة في الخصومة ، وليس مجرد قالب كالشكليات التي كانت تعرفها بعض القوانين القديمة .
هذا إلى أن الشكل ليس هو الإجراء ، ذلك أن الإجراء أو العمل الإجرائي هو عمل قانوني يجب أن تتوافر فيه شروط معينة من بينها الشكل الذي يحدده القانون – وترتيبا على ما تقدم فإنه إذا أوجب القانون توافر الشكل أو بيان في الإجراء فإن مناط الحكم بالبطلان هو التفطن إلى مراد المشرع من هذه البيانات وما يستهدفه من تحقيق غاية معينة .
(10/5/1980 – م نقض م – 31 – 1325)
لئن كان الشكل أو البيان وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة وكان لا يقضي بالبطلان ولو كان منصوصا عليه ، إذا أثبت المتمسك ضده فه ، تحقق الغاية عملا بالفقرة الثانية من المادة 20 مرافعات إلا أن التعرف على الغاية من الشكل أو البيان وتحديد ماهية هذا الغاية مسألة قانونية يتعين على محكمة الموضوع التزام حكم القانون بشأنها فإذا أجنحت عنها إلى غاية أخرى وانتهت في حكمها إلى ثبوت تحقق الغاية ، ورتبت على ذلك رفض القضاء بالبطلان لتحقق الغاية فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(10/4/1983 طعن 1728 سنة 49ق – م نقض م – 33 – 921)
النص في الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات مفاده أن المشرع قدر أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة من توافر هذا الشكل أو البيان ، فإذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف الشكل أو البيان فإنه من التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان .
(20/2/1986 طعن 1184 لسنة 52ق – م نقض م – 37 الجزء الأول – 246)
والمقصود هو الغاية الموضوعية المجردة ، أى التي قصد الشارع إلى تحقيقها فيتعين النظر إلى الغاية – في معرض قيام موجب البطلان – كوظيفة للشكل حسبما قصد القانون من تقريره دون نظر للغاية الشخصية التي قد يستهدفها القائم بالعمل .
والخلاصة أن القانون الجديد جعل العبرة في الحكم بالبطلان سواء كان منصوصا عليه أو غير منصوص عليه يتحقق الغاية من الشكل المعيب أو عدم تحققه والمقصود بالغاية هى الغاية الموضوعية أى الوظيفة الإجرائية التي قصد الشارع من تقرير الشكل توافرها .
ويقوم موجب البطلان بأن يثبت المتمسك بالبطلان المنصوص عليه أن عيبا لحق أحد أشكال العمل الإجرائي الذي قام به خصمه فتقوم لصالحه قرينة بسيطة على تخلف الغاية من الشكل المعيب أو أن يثبت التمسك بالبطلان غير المنصوص عليه أن عيبا قد لحق بأحد أشكال العمل الإجرائي الذي قام به خصمه وأنه مثل هذا العيب تترتب عليه في الخصومة المجردة – بغض النظر عن الواقعة المعروضة – تخلف الغاية من هذا الشكل .
ولكن من قام بالعمل الإجرائي يملك في الحالين تجنب الحكم بالبطلان بإثبات قيام سبب التصحيح ، وذلك بأن يثبت أنه رغم تعيب الشكل – سواء كان البطلان منصوص عليه – فقد تحققت في خصوص الواقعة المعروضة الغاية الموضوعية التي يستهدفها الشارع من تقرير ذلك الشكل .
يتضح من ذلك عدم دقة إطلاق القول بأن كل الفارق بين البطلان المنصوص عليه والبطلان غير المنصوص عليه يتحدد في عبء إثبات تخلف أو تحقق الغاية ، والصحيح أن الفارق يتحدد في مدى هذا العبء ، إذ أن كل ما على من يتمسك بالبطلان غير المنصوص ع ليه زيادة على حالة البطلان المنصوص عليه ، أن يثبت أن الغاية لا يتحقق في الخصومة المجردة بسبب ما أثبته من تعيب الشكل .
الغش والبطلان الإجرائي
من المبادئ الأساسية في القانون الطبيعي أن (الغش يفسد كل شيء)
وهى تتمشى مع مبادئ العدالة لأنها تقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية ، وتحارب الخديعة والاحتيال على القانون والانحراف عنه ، ويعمل بها في جميع فروع القانون صيانة لمصالح الأشخاص في المجتمع ، ويعمل بها بصدد جميع التصرفات القانونية والإجراءات بغير نص ، وذلك استنادا إلى المادة الأولى من القانون المدني التي تنص على أنه إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف .
فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ، وإذا وجد نص تشريعي في القانون المدني أو قانون المرافعات يوجب أعمال جزاء معين عند الغش وجب إعماله – مثال ذلك
- الادعاء بغش القاضي يوجب إقامة الدعوى بمخاصمته (مادة 494)
- الادعاء ببناء الحكم على الغش يوجب بشروط معينة عند إقامة الطعن عليه بالتماس إعادة النظر (م 241)
- الغش عند اختيار خصوم الدعوى أو الطعن يوجب على المحكمة من تلقاء نفسها تصحيح شكلها (م 168 ، 218)
- الكيد عند الإدلاء بالطلبات والدفوع يوجب الحكم بالتعويضات (م 188)
- تقرير غير الحقيقة من جانب المحجوز لديه يجيز الحكم عليه بدين الحاجز عملا بالمادة 343 .
وإذا كان قانون المرافعات قد أوجب في الإجراءات مواعيد وبيانات وأوضاع وأشكال معينة ، وذلك ضمانا لما تحققه هذه الإجراءات من مصالح قانونية ، وإذا كان قانون المرافعات قد رتب البطلان جزاء عدم تحقق الغاية من الشكل الذي يتطلبه في الإجراء جزاء النقص يعتريه أو الخطأ الذي يصيبه ، فمن باب أولى يترتب هذا البطلان إذا تعمد الخصم حرمان خصمه من تلك الضمانات .
وبعابرة أخرى ، إذا كان الغش – كقاعدة عامة – هو تغيير الحقيقة بأية وسيلة بقصد تحقيق مصلحة خاصة تتعارض مع القانون ، فإن هذا الغش ، وعلى هذا المعنى ، يؤدي إلى بطلان الإعلانات والإجراءات على وجه العموم إذا شابها وإذا لم يتحقق في هذه الإجراءات – بسب الغش – ما قصد القانون إلى حمايته بما أوجبه وحصلت فيه المخالفة .
ولهذه القاعدة الأساسية شعاب ، منا عدم الاعتداد بالديانة الجديدة التي يعتنقها الخصم بعد إقامة الدعوى إلى القضاء لمجرد الاحتيال على القانون ولمجرد التحلل مما تفرضه عليه ديانته أو مذهبه ….. الخ ومنها بطلان الإعلان إذا تسلمه من تتعارض مصلحته مع المراد إعلانه .
ومنها بطلان تقرير الخبير إذا تعمد وصف وقياس محل النزاع بغير ما يتصف به تحقيقا لمصلحة خاصة أو لزيادة الأجرة القانونية أو لانتقاصها عن عمد ….. الخ ، ومنها انعدام إعلان صحيفة الدعوى إذا أعلن بها المدعى عليه في موطن وهمي له غشاء ، وبالتالي انعدام الحكم الصادر فيها ، ومنها الحكم بالتعويض إذا قصد من الإشكال الوقتي أو الموضوعي مجرد عرقلة إجراءات التنفيذ .
التمسك بالبطلان في القضايا المدنى
الأصل أن البطلان لا يقع بقوة القانون وإنما يجب أن تقضي به المحكمة بناء على طلب صاحب الشأن فيه . فالإجراء المعيب يبقى قائما منتجا كل آثاره الى أن يحكم ببطلانه .
ولا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته ، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه . (مادة 21 من القانون الجديد) وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 13 لسنة 1968 :
أما المادة 21 فتتناول بيان قاعدة مستقرة في الفقه والقضاء مؤداها أن البطلان لا يتمسك به إلا من شرع لمصلحته ولا يجوز أن يتمسك به من تسبب فيه ، ويستوي أن يكون من تسبب في البطلان هو الخصم نفسه أو شخص آخر يعمل باسمه .
كما يشترط أن يكون قد صدر من الخصم غش أو خطأ بل تكفي مجرد الواقعة التي تؤكد نسبة البطلان الى الخصم أو من يعمل باسمه .
ومن ناحية أخرى فإنه لا يقصد بعبارة (من تسبب) أن يكون فعل الخصم هو السبب الرئيسي أو الوحيد أو السبب العادي لوجود العيب في الإجراء.
كما لا يشترط أن يكون هو السبب المباشر ، وقد حرصت المادة ذاتها على استثناء البطلان المتعلق بالنظام العام ، إذ أن هذا البطلان لا يقتصر التمسك به على من شرع لمصلحته ، ويجوز التمسك به حتى من الخصم الذي تسبب فيه رعاية للمصلحة العامة التي تعلو أى اعتبار آخر ” .
ويلاحظ بالنسبة الى البطلان المتعلق بالنظام العام التفرقة بين حكم هذه المادة وحكم الفقرة الأخيرة من المادة 20 التي تمنع عند تحقق الغاية الحكم بالبطلان ولو كان متعلقا بالنظام العام إذ في هذه الحالة الأخيرة يكون تحقق الغاية دليلا على عدم المساس بالنظام العام ، وبمعنى آخر فإن إعمال المادة 21 يفترض قيام موجب البطلان وعدم تحقق الغاية لأنه إذا تحققت الغاية امتنع الحكم بالبطلان سواء كان متعلقا بالنظام العام أو غير متعلق به .
نجد أن التمسك بالبطلان الذي لا يتعلق بالنظام العام المقرر لحماية المصلحة الخاصة تحكمه قاعدتان أساسيتان
القاعدة الأولى: أن الحق في التمسك بالبطلان يقتصر على من شرع البطلان لمصلحته فلا يكون لغيره ولا للنيابة العامة التمسك به كما لا يكون للقاضي إثارته من تلقاء نفه وهو ما جرى عليه القضاء في ظل القانون الملغي.
(5/1/1967 – م نقض م – 18 – 92 – 25/5/1967 – م نقض م – 18 – 1102 – 31/5/1956 – م نقض م – 7 – 622)
وتطبيقا لذلك فإنه لا يجوز لمن صح إعلانهم من الخصوم التمسك ببطلان إعلان غيرهم ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة إذ أن إفادتهم من هذا البطلان مرهونة بثبوته بالطريق القانوني وهو ما يستلزم أن يتمسك به من تعيب إعلانه وأن تقضي به المحكمة .
(12/1/1977 – م نقض م – 28 – 229 – 26/10/1965 – م نقض م – 16 – 902 – 25/4/1963 – م نقض م – 14 – 579)
وقد قضت محكمة النقض بأنه
مفاد المادة 21/1 من قانون المرافعات أن الحق في التمسك بالبطلان إعلان أوراق المحضرين يقتصر على من شرع البطلان لمصلحته فلا يكون لغيره التمسك به ولا يجوز لمن صح إعلانهم من الخصوم التمسك ببطلان إعلان غيرهم إلا أنه إذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن لمن صح إعلانهم من الخصوم الإفادة من هذا البطلان إذا تمسك به من تعيب إعلانه وقضت به المحكمة.
(16/5/1981 طعن 6380/1094 سنة 47 ق – م نقض م – 33 – 15/11/1981 طعن 514 سنة 46ق الخمسين عاما المجلد الثاني – 1586 – 259 – 16/2/1982 طعن 6 سنة 51ق – 15/2/1984 طعن 353 سنة 50ق – 27/3/1985 طعن 972 سنة 51ق – 28/2/1985 طعن 886 سنة 51ق – 26/2/1985 طعن 264 سنة 59ق)
لا يجوز للخصم التمسك بالبطلان لعدم إعلان غيره بتعجيل الدعوى أو بإيداع تقرير الخبير .
(5/12/1985 طعن 300 سنة 52ق – 15/5/1984 طعن 393 سنة 50ق – م نقض م – 35 – 1310)
أو بالبطلان المترتب على قرار المحكمة التصريح بمذكرات ومستندات قبل إعادة إعلان غيره .
(15/1/1989 طعن 2134 سنة 52 ق)
أو ببطلان إعلان غيره بأوراق التكليف بالحضور .
(16/2/1982 طعن سنة 51ق)
ومنا إنذار إبداء الرغبة في الشفعة (8/2/1984 طعن 491 سنة 47ق)
أو بالبطلان المترتب على عدم إعلان غيره بقرار إعادة الدعوى للمرافعة إذ مادامت الخصومة قد انعقدت صحيحة فإن البطلان بسبب الإجراءات اللاحقة بطلان نسبي.
(12/1/1977 طعن 403 لسنة 43ق – م نقض م – 28 – 224)
أو ببطلان إعلان غيره بصحيفة الاستئناف لإجرائه في غير موطنه .
(5/1/1967 – م نقض م – 18 – 92)
أو بالبطلان المترتب على عدم إعلان غيره بحكم التحقيق.
(5/1/1967 – م نقض م – 18 – 92)
أو بالبطلان المترتب على إغفال أخبار النيابة بوجود قصر في الدعوى لأنه حكم مقرر لمصلحتهم.
(15/5/1967 – م نقض م – 18 – 1102)
وتمسك صاحب الشأن بالبطلان الذي لا يتعلق بالنظام العام يخضع لحكم المادة 108 مرافعات فيجب التمسك به قبل التعرض للموضوع أو إبداء الدفع بما لم يتمسك له فيها مع قيام سبب وإذا تعددت أوجه الدفع الواجب وجب التمسك بها كلها معا وإلا سقط الحق في التمسك بالوجه الذي أغفل التمسك به .
كما يسقط الحق في الدفع أو الوجه الذي يغفل التمسك به في صحيفة الطعن ، ولازم ذلك أن المحكمة لا تملك التعرض للبطلان من تلقاء نفسها ، كما أنها لا تملك التعرض لغير الدفع أو الوجه الذي تمسك به صاحب الشأن .
وقد قضت محكمة النقض بأنه
لا يجوز القضاء ببطلان الإعلان النسبي لغير الود الذي تمسك به صاحب الشأن فإذا كان قد اقتصر في النعى على الإعلان بالبطلان على عدم صحة البيان الخاص بإخطاره بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة ، فلا يجوز القضاء ببطلان الإعلان استنادا إلى إغفال المحضر إثبات الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إلى جهة الإدارة .
(9/5/1978 – م نقض م – 29 – 1197)
ومن جهة أخرى فإنه إذا كان الأصل في الإجراءات الصحيحة فإنه إذا لم يتمسك صاحب الشأن بالبطلان الذي لا يتعلق بالنظام العام أو سقط حقه في التمسك به فإن الإجراء يعتبر قائما صحيحا منتجا لآثاره .
وقد قضت محكمة النقض بأنه
البطلان الناشئ عن عدم مراعاة إجراءات الإعلان بطلان نسبي لا يعدم الحكم بل يظل قائما موجودا وإن كان مشوبا بالبطلان فينتج آثاره ما لم يقض ببطلانه بالطعن عليه بإحدى طرق الطعن المقررة قانونا فإن مضت مواعيد الطعن أو كان غير قابل لهذا الطعن فقد أضحى بمنحى من الإلغاء حائزا لقوة الشيء المقضي دالا بذاته على صحة إجراءاته.
(23/4/1970 – م نقض م – 21 – 689 – 5/4/1977 طعن 119 لسنة 43ق – م نقض م – 28 – 909)
ولا يجوز التمسك بالبطلان لأول مرة أمام محكمة النقض.
(25/12/1971 – م نقض م – 22 – 234)
ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
(5/4/1977 – م نقض م – 18 – 909 – 16/3/1977 – م نقض م – 28 – 697)
القاعدة الثانية : أنه ليس لمن كان سببا في بطلان العمل الإجرائي أن يتمسك ببطلانه سواء كان هو الذي تسبب فيه بنفسه أو كان الذي تسبب فيه شخص يعمل باسمه كالمحامي أو المحضر أو النائب القانوني أو النائب العام الاتفاقي .
وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية أنه لا يشترط لذلك أن يقع من الشخص غش أو خطأ أو أن يكون فعله هو السبب الرئيسي أو الوحيد أو العادي أو المباشر وإنما يكفي أن تقوم بين عمله وبين العيب الذي لحق الإجراء رابطة سببية.
وهى تقوم إذا كان العمل لازما لوجود العيب فتتوافر من ثم الرابطة ولو كان فعله هو الذي أدى إلى وقوع الخصم في خطأ أدى إلى بطلان إجراء قام به هذا الأخير ، وقد قضى تطبيقا لذلك بأن الخصم الذي يتسبب في تأجيل إجراء التحقيق لا يجوز له أن يتمسك بعدم جواز إجرائه لفوات ميعاده .
قضت محكمة النقض بأنه
إذا كانت المادة 128 مرافعات بعد أن أجازت وقف الدعوى باتفاق الطرفين أوجبت في فقرتها الثانية تعجليها في ثمانية الأيام التالية لنهاية أجل الإيقاف وإلا اعتبر المدعى تاركا لدعواه والمستأنف تاركا لاستئنافه ، وكانت المادة 12 من ذات القانون قد نصت في فقرتها الثانية على أنه إذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة .
وإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة كانت قد اتخذت موطنا لها بمدينة القاهرة منذ بدء الخصومة إلا أنها قامت بتغييره أثناء فترة الوقف ولم تخطر المطعون ضده الأول بهذا التغيير فقام بتوجيه إعلان تعجيل الاستئناف إليها في موطنها المعروف له في ميعاد ثمانية الأيام التالية لنهاية أجل الوقف وإذ جاءت الإجابة بانتقالها إلى الإسماعيلية وجه إليها إعلانا آخر بتلك المدينة فجاءت الإجابة بعدم الاستدلال عليها .
فقام بإعلانها أخيرا في موطنها الذي انتقلت إليه ببور سعيد وكان ميعاد التعجيل قد انقضى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يجوز للشخص أن يفيد من خطئه أو إهماله وكانت المادة 21/2 من قانون المرافعات لا تجيز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه إلا إذا تعلق بالنظام العام وكان لا يشترط لإعمال هذه القاعدة أن يكون فعل الخصم هو السبب الرئيسي أو السبب الوحيد أو السبب العادية لوجود العيب في الإجراء .
كما لا يشترط أن يكون هو السبب المباشر ، وكانت الطاعنة قد خالفت القانون بعدم إخطارها المطعون ضده الأول بتغيير موطنها أثناء فترة الوقف مما أدى إلى تعذر قيامه بإعلانها بتعجيل الاستئناف من الإيقاف في الميعاد المقرر في القانون فلا يكون لها أن تتمسك باعتبار المطعون ضده الأول تاركا لاستئنافه إذ لا يجوز لها أن تفيد من خطئها الذي تسببت فيه فيما شاب إجراء التعجيل من عيب.
(5/12/1983 طعن 1289 سنة 49 ق)
وبأنه ” مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون المرافعات – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أن البطلان لا يجوز أن يتمسك به من تسبب فيه ، ويستوي أن يكون من تسبب في البطلان هو الخصم نفسه أو شخص آخر يعمل باسمه كما أنه لا يشترط أن يكون قد صدر من الخصم غش أو خطأ ، بل تكفي مجرد الواقعة التي تؤكد نسبة البطلان إلى الخصم أو من يعمل باسمه .
(31/5/1980 – م نقض م – 31 – 1619)
التمسك بانعدام العمل في قانون المرافعات
لا يسري هذا الحكم على الإجراء المعدوم أو الباطل بطلانا متعلقا بالنظام العام فيجوز التمسك به لكل ذي شأن ولو كان من تسبب فيه :
قضت محكمة النقض بأنه
عدم جواز التمسك ببطلان الإجراء من الخصم الذي تسبب فيه وفقا لنص المادة 21 من قانون المرافعات قاصرا على حالة بطلان الإجراء غير المتعلق بالنظام العام أما إذا كان بطلان الإجراء متعلقا بالنظام العام أو كان الإجراء معدوما فإنه لا يرتب أثر ويجوز لهذا الخصم التمسك بانعدام آثاره في جميع الأحوال ولما كان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى الحالية قد وجه إلى إدارة قضايا الحكومة وهى لا تنوب عن الشركة الطاعنة فإن هذا الإعلان يعتبر معدوما ويكون الحكم الصادر بناء عليه معدوما هو الآخر .
(24/4/1978 – م نقض م – 29 – 1088)
وبالنسبة للتمسك بالبطلان المتعلق بالنظام العام فيجوز للنيابة التمسك به سواء كانت طرفا أصليا أو منضما كما يجوز ذلك لكل ذي مصلحة حتى ولو كان هو الذي قام بالعمل الباطل كما يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .
ونختلف طرق التمسك بالبطلان باختلاف الإجراء المعيب . فإذا كان الإجراء المعيب من إجراءات الخصومة فإن التمسك ببطلانه يحصل بإبداء دفع شكلي مع مراعاة أن حضور الخصم يزيل بطلان صحيفة الدعوى أو ورقة التكليف بالحضور وفقا للمادة 114 ويسقط صراحة في التمسك بالبطلان.
ويزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا (مادة 22) أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتباره صحيحا أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك ، كان يناقش أحد الخصوم ما جاء بتقرير الخبير فيعتبر هذا ردا على ما جاء في التقرير ويفيد بأن الخصم قد اعتبره صحيحا .
مما يترتب عليه زوال البطلان الذي يشوب عمل الخبير هذا إذا كان البطلان ناشئا عن مخالفة القواعد المقررة لصالح الخصوم خاصة ، أما إذا كان البطلان متعلقا بالنظام العام فإنه يجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى ويجوز للنيابة أن تتمسك به إذا كانت طرفا منضما في الخصومة .
وإذا كان البطلان واردا على حكم من الأحكام ، فإن التمسك ببطلانه يحصل عن طريق الطعن فيه بطرق الطعن المقررة في القانون ، فإذا انقضى ميعاد الطعن زالت عن الحكم (وعن الإجراءات السابقة عليه) كل الشوائب التي تعيبه .
وتجب التفرقة بين الأحكام الباطلة والأحكام المعدومة فالأخير لا يلزم الطعن فيها بل ولا يلزم رفع دعوى بطلب بطلانها ويكفي إنكارها والتمسك بعدم وجودها ، على أنه من الجائز إقامة دعوى أصلية بطلب بطلانها ، ومن أمثلة هذه الأحكام الحكم الذي لا يوقع عليه رئيس الهيئة التي أصدرته ولا كاتبها والحكم الصادر من هيئة مكونة من قاضيين بدلا من ثلاثة قضاة ، والحكم الصادر في دعوى أقيمت على متوفى .
زوال البطلان
يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام (م23 مرافعات) .
فيلاحظ أن المادة 22 مرافعات قد حددت زوال البطلان بالنزول عن البطلان فتقرر جواز النزول عنه صراحة أو ضمنا باستثناء ما تعلق بالنظام العام .
وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 13 لسنة 1968 أنه ” وتقنن المادة 22 من المشروع النزول عن البطلان فتقرر جواز النزول عنه صراحة أو ضمنا باستثناء ما تعلق بالنظام العام وهو نص يفضل في صياغته نص المادة 26 من قانون المرافعات الحالي الذي آثار خلافا في الفقه بشأن تغيير عبارته ” .
ويكون النزول الصريح بإعلان الخصم إرادته النزول عن حقه في التمسك بالبطلان سواء أكان بإرادته المنفردة أو نتيجة اتفاق بينه وبين خصمه مادام الاتفاق حاصلا بعد قيام سبب البطلان أما الاتفاق مقدما على النزول عن البطلان فيميل الرأى الغالب إلى أجازته إذا كان محددا ببطلان عمل معين ولسبب معين .
أما إذا كان الاتفاق عاما غير محدد بطلان عمل معين أو غير محدد بسبب معين فلا يجوز لأن الخصم ينزل عن البطلان صراحة يكون ضمنيا .
والنزول الضمني هو المستفاد من سلوك الخصم سلوكا يدل على إرادته النزول عن التمسك بالبطلان كالنزول عن التمسك ببطلان التنفيذ على العقار في يد حائزه الناشئ عن عدم إنذار الحائز المستفاد من تدخل الحائز وطلبه التأجيل لسداد الدين ومن صور النزول الضمني عن التمسك بالبطلان التعرض للموضوع أو إبداء دفع بعدم القبول قبل التمسك بالبطلان .
ومتى تم النزول عن البطلان صراحة أو ضمنا فإنه يقع باتا فلا يجوز العدول عنه أو التحلل من آثاره .
(16/3/1977 – م نقض م – 28 – 697 – 25/4/1972 – م نقض م – 13 – 768 – 6/12/1978 – م نقض م – 29 – 1850)
تصحيح الإجراء الباطل
يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه . (مادة 23 مرافعات)
جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 13 لسنة 1968 :
تتناول المادة 23 الحكم الخاص بتصحيح الإجراء الباطل وهو ما نص عليه القانون رقم 100 لسنة 1962 من أن التصحيح لا ينتج أثره إلا من تاريخ حصوله ولا يرجع إلى تاريخ القيام بالإجراء الذي لحقه التصحيح .
فقد ورد بالمذكرة التفسيرية للقانون رقم 100 لسنة 1962 الذي استحدث حكم المادة 23 ومن تطبيقاتها أن
يحضر الوصى في الجلسة المحددة لنظر الدعوى المرفوعة من القاصر أو المرفوعة عليه فيصحح حضوره إجراءات الدعوى وأن يحضر باقي مديري الشركة في الدعوى المرفوعة من أحدهم إذا كان تمثيلها قانونا لا يتم إلا بهم مجتمعين ، وكذلك إذا كانت صحيفة الاستئناف غفلا من توقيع محام مقبول في الاستئناف فإنه يجوز استيفاء التوقيع في الجلسة متى كان ذلك في خلال ميعاد الاستئناف ، ذلك لأن توقيع المحامي على الصحيفة يعد وحده وفي ذاته الدليل على صياغتها بواسطته فيستوي أن يكون التوقيع عليها قد تم وقت كتابتها أو في الجلسة .
والمقصود بالتصحيح المنصوص عليه في المادة 23 مرافعات هو تصحيح البطلان بتكملة الإجراء المعيب ولو بعد التمسك بالبطلان ويفرق نص المادة بين حالتين :
الأولى إذا كان للإجراء ميعاد معين وجب أن يحصل التصحيح بالتكملة في الميعاد فصحيفة الاستئناف يجب توقيعها من محام مقبول أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف إنما يجوز تصحيح البطلان الناشئ عن مخالفة هذا الإجراء بتوقيع الصحيفة من محام مقرر في جلسة المرافعة بشرط أن يتم ذلك في ميعاد الاستئناف .
الثانية ألا يكون للإجراء ميعاد مقرر وهنا تحدد المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه كما إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلان بالصحيفة أجلت القضية إلى جلسة تالية يعاد إعلانه لها إعلانا صحيحا (مادة 58 مرافعات)
- ومن المقرر أنه لا يمنع من التصحيح المشار إليه في تلك المادة أن يكون الخصم قد تمسك بالبطلان إلا أن الإجراء لا ينتج أثره إلا من تاريخ تصحيحه
- كذلك لا يمنع من التصحيح أن يكون الإجراء متعلقا بالنظام العام مادام الميعاد الذي حدده القانون لإتمام الإجراء مازال قائما كما في حالة رفع الاستئناف بدون التوقيع على صحيفته من محام مقبول أمام المحكمة الاستئنافية فيجوز تصحيح البطلان بتوقيع المحامي إذا كان ميعاد الاستئناف لم ينته بعد .
- ويلاحظ أن قيام الخصم بتحديد الإجراء ظنا منه أن عيبا قد لحقه لا يمنع الحكم من اعتبار الإجراء الأول صحيح وينتج أثره من تاريخ اتخاذه متى رأت المحكمة خلوه من العيوب .
وإذا كان الأصل أن الذي يقوم بتصحيح الإجراء من قام به إلا أنه قد يتم تصحيح الإجراء فيزول عيبه بعلم أو إجراء يقوم به من وجه إليه
كما إذا رفعت الدفع على قاصر وحضر وصية وقام بموالاة إجراءاتها غير أن هذا النص لا يسري على الحالات التي ينص فيها القانون على اعتبار الإجراء كأن لم يكن أو على سقوطه بقوة القانون كحالة سقوط الخصومة أو اعتبارها كأن لم تكن بسبب فوات ميعاد معين إذ يقع البطلان بقوة القانون ولا يجدى تصحيحه .
وقد يرد التصحيح على دعوى غير مقبولة وليس على دعوى صحيفتها باطلة فحسب ، كما إذا حضر باقي مديري شركة في دعوى مرفوعة من أحدهم إذا كان تمثيلها قانونا لا يتم إلا بهم مجتمعين ومن أمثلة التصحيح بالتكملة أن يقوم المدعى بإعادة إعلان صحيفة الدعوى مستوفية لما أغفله من بيانات عند إجراء الإعلان الأول وإذا تم التصحيح باطلا وأمرت المحكمة مرة ثانية بالتصحيح فإنه ينصب على الإجراء الأخير ويعد تصحيحا أل إذا كان البطلان لسبب غير السبب الذي رتب البطلان الأول .
ويستوي أن يكون العيب موضوعيا كعيب الأهلية أو التمثيل القانوني أو عيبا شكلا كبعض بيانات الصحيفة كما يستوي أن يكون البطلان متعلقا بالمصلحة الخاصة أو النظام العام ويتعين أن يتم التصحيح في ذات مرحلة التقاضي الذي اتخذ فيها الإجراء موضوع التصحيح .
ولا يشترط في التجديد تقرير بطلان العمل الأول أو حتى ثبوت عيبه كما يلزم إذن القاضي للقيام به ولا يعني التجديد أو يستلزم إلغاء العمل الأول أو سحب من أجراه له إذ أنه لا يملك ذلك لأن القانون الخاص لا يعرف نظام السحب الذي يعرفه القانون الإداري ومن ثم يجوز إجراء التجديد على سبيل الاحتياط وتملك المحكمة رغم القيام به أن تعتد بالعمل الإجرائي الأول متى رأت خلوه من العيوب .
والشرط الوحيد للقيام بالتجديد أن يكون ممكنا أى ألا يكون مستحيلا والاستحالة قد تكون مادية كأن تهلك الأشياء موضوع عمل الخبير بعد بطلان تقريره كما قد تكون الاستحالة قانونية كانقضاء الميعاد المحدد لمباشرة الإجراء.
(8/12/1971 – م نقض م – 22 – 1005 – 12/7/1972 – م نقض م – 23 – 1175)
فتصحيح المدعى الدعوى في حال صاحب الصفة الحقيقي فيها لا يكون له أثر إلا إذا تم خلال الميعاد المحدد لرفع الدعوى .
(12/2/1980 طعن 352 سنة 46ق – م نقض م – 31 – 481)
يلزم في الإجراء الجديد أن يكون صحيحا لأن الإجراء الباطل لا يصححه إجراء باطل ولو اختلف سبب البطلان
قضت محكمة النقض بأنه
تصحيح الإجراء الباطل يجب أن يتم في ذات مرحلة التقاضي التي اتخذ فيها هذا الإجراء فالبطلان الناشئ عن عدم توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى ينبغي أن يتم تصحيحه أمام محكمة الدرجة الأولى وقبل صدور حكمها الفاصل في النزاع إذا بصدور هذا الحكم يخرج النزاع من ولاية المحكمة ويمتنع إجراء التصحيح ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن توقيع المحامي على صحيفة افتتاح الدعوى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف من شأنه تصحيح البطلان العالق بهذه الصحيفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون “
(2/2/1967 – م نقض م – 27 – 356)
تجزئـة البطلان الإجرائى
إذا كان الإجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحا باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره وإذا كان الإجراء باطلا في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه (م24 مرافعات)
جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 13 لسنة 1968 :
أما المادة 24 فتكلم عن آثار البطلان وهى تشتمل على ثلاث فقرات تحتوي كل منها على قاعدة مستقلة ، الفقرة الأولى : تنظيم ما يعرف بتحول العمل الباطل فإذا كان الإجراء باطلا وتوافرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يتحول إلى هذا الإجراء الآخر وتنظم الفقرة الثانية انتقاص العمل الباطل فإذا كان شق من الإجراء غير معيب.
فإنه يمكن أن يبقى صحيحا رغم تعيب الآخر أما الفقرة الثالثة فهى التي تتناول أثر بطلان الإجراء على الإجراءات السابقة والتالية له فلا ينحسب هذا الأثر على الإجراءات المترتبة على الإجراء الباطل ويلاحظ أن عبارة (مبينة عليه) لا تعني مجرد الارتباط المنطقي بل يجب وجود ارتباط قانوني بين العملين بحيث يعتبر العمل السابق الذي يظل شرطا لصحة اللاحق عليه .
والانتقاص طبقا للقانون الجديد لا يرد إلا على العمل الإجرائي المركب من أجزاء قابلة للتجزئة أو الانقسام دون العمل الإجرائي البسيط أو غير القابل للتجزئة أو الانقسام فتعييب شق من العمل الإجرائي من هذا النوع الأخير يؤدي إلى بطلان العمل الإجرائي كله .
(28/5/1955 – م نقض م – 6 – 1178 – فتحي والي بند 373 – سيف بند 597 – نصر الدين كامل وعبد العزيز يوسف في المدونة الجزء الثاني بندى 870 ، 955 وقارن أبو الوفا في المدونة بند 955 ونظرية الدفوع بند 157)
قضت محكمة النقض بأنه
إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الإجراء باطلا في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل فهى تنظم انتقاص العمل الباطل بحيث إذا كان شق من الإجراء غير معيب فإنه يمكن أن يبقى صحيحا رغم تعييب الآخر ولا يرد هذا الانتقاص إلا على العمل الإجرائي المركب من أجزاء قابلة للتجزئة أو الانقسام دون العمل الإجرائي البسيط أو غير القابل للتجزئة أو الانقسام فتعييب شق من العمل الإجرائي من هذا النوع الأخير يؤدي إلى البطلان العمل الإجرائي كله “
(17/5/1977 طعن 698 سنة 42ق – م نقض م – 28 – 1230 – 28 – 1230 – 28/5/1972 – م نقض م – 6 – 1178)
ويلاحظ أن نص القانون الجديد لم يورد ما يتضمنه نص المادة 143 من التقنين المدني من عدم جواز الانتقاص إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الباطل فيتعين بطلان العمل كله ولو كان قابلا للانقسام ، ومن ثم محل لإعمال هذا القيد بالنسبة إلى الأعمال الإجرائية .
ذلك أن هذا القيد يرجع بالنسبة إلى التصرفات القانونية إلى أن الإرادة تستقل بتحديد آثارها ، ويكون الانتقاص في شأنها إعمالا للإدارة المفترضة للمتعاقدين برضائهما الاقتصار على آثار الأجزاء الصحيحة ومن ثم ينتفي مبرر الانتقاص متى ثبت عكس هذه الإرادة المفترضة بثبوت أن الشق المعيب كان هو الدافع الى التعاقد كله وواضح أنه لا محل لكل ذلك بالنسبة الى الأعمال الإجرائية التي يستقل القانون بتحديد آثارها .
ومن المقرر أن العمل الإجرائي يظل صحيحا منتجا آثاره حتى يتقرر بطلانه بحكم القضاء سواء كان البطلان متعلقا بالنظام العام أو كان غير متعلق به، وسواء كان البطلان منصوصا عليه صراحة أو غير منصوص عليه ، وسواء كان العيب الذي شابه ذاتيا أى وارد على العمل الإجرائي ذاته أو مستمدا من بطلان عمل آخر .
كذلك فإن العمل الإجرائي الذي يتقرر بطلانه لا ينتج أى أثر فلا تقطع صحيفة الدعوى التقادم ولا يفتتح إعلان الحكم ميعاد الطعن وهى قاعدة مطلقة بالنسبة الى الآثار التي ينتجها العمل لصالح من قام به ، إلا أن هذا العمل الذي تقرر بطلانه قد ينتج مع ذلك بعض الآثار ضد من قام بالعمل فالطاعن الذي لا يتمسك في صحيفة الطعن ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه يسقط حقه في التمسك بهذا الدفع ولو قضى بعد ذلك ببطلان صحيفة طعنه .
ومن المقرر وفقا لصريح نص الفقرة الأخيرة أن بطلان العمل الإجرائي لا أثر له على الأعمال السابقة عليه متى تمت صحيحة في ذاتها
ومؤدى ذلك أن بطلان إعلان الحكم لا يؤثر على صحة الحكم غير أن الحكم ببطلان صحيفة الدعوى يترتب عليه بطلان إعلان الإجراءات اللاحقة عليها باعتبارها مبنية عليها بما فيها الحكم الصادر في الدعوى . كما أن بطلان صحيفة الطعن يترتب بطلان الحكم الصادر فيه غير أن بطلان الحكم لا يرتب بطلان الإجراءات السابقة عليه كما أنه لا يؤثر بطلان الإجراء في الإجراءات التالية له إذا كان لها كيان مستقل بذاتها ولم تكن معتمدة عليه
ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه طبقا لما تنص عليه المادة 21/2 مرافعات .
وإذا كان العمل اللاحق مستقلا عن العمل السابق الذي تقرر بطلانه فلا تأثير عليه من هذا البطلان فترك الخصومة من المدعى والحكم الصادر بتقرير هذا الترك صحيحين ولو كانت صحيفة افتتاح الدعوى باطلة .
ويشترط في الأعمال اللاحقة التي تؤثر في العمل السابق وجود ارتباط يجعل العمل السابق شرطا لصحة العمل اللاحق ولا يكفي مجرد الارتباط المنطقي بين العملين وإنما يلزم الارتباط القانوني بينهما وعلى ذلك فإن بطلان الحكم الابتدائي يؤدي الى بطلان الحكم الاستئنافي الذي قضى بتأييده .
ونجد المادة 25 مرافعات تشترط توقيع الكاتب على محضر الجلسة وإلا كان العمل باطلا ، فتنص على أنه: يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي وإلا كان العمل باطلا .
العبرة في إثبات إجراءات نظر الدعوى بما هو ثابت بمدونات الحكم مكملا بما ورد في محضر الجلسات
قضت محكمة النقض بأنه
من المقرر أن العبرة في خصوص إثبات إجراءات نظر الدعوى بما هو ثابت منها بمدونات الحكم ومحاضر الجلسات “
(5/2/1985 طعن 2036 لسنة 50ق – م نقض م – 36 – 210)
لا تكتمل صفة الرسمية لمحضر الجلسة ألا بتوقيع القاضي ، فيبطل الحكم إذا صدر استنادا الى محضر لم يوقع من القاضي
قضت محكمة النقض بأنه
النص في المادة 93 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وفي المادة 25 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب أن يكون محضر التحقيق الذي يباشر من القاضي موقعا منه وإلا كان باطلا ، لأن هذا المحضر باعتباره وثيقة رسمية لا يعدو أن يكون من محاضر جلسات المحكمة.
وهو بهذه المثابة لا تكتمل له صفته الرسمية إلا بتوقيع القاضي ويترتب على ذلك أن الحكم الذي يصدر استنادا الى محضر تحقيق لم يوقع من القاضي الذي باشره يكون مبنيا على إجراء باطل وهو بطلان من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض بل أن لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها .
لما كان ذلك ، وكان البين من الإطلاع على ملف الاستئناف رقم 100 لسنة 32 المنصورة المنضم للطعن أن محضر التحقيق المؤرخ 21/1/1984 والذي تضمن أقوال شهود الطرفين قد خلا من توقيع السيد المستشار المنتدب للتحقيق ، وإذ كان الحكم المطعون قد الصادر بجلسة 22/4/1984 قد أقام قضاءه على سند من أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى اللذين سمعا بمحضر التحقيق سالف الذكر فإنه يكون باطلا لابتنائه على إجراء باطل بما يوجب نقضه.
(30/1/1985 طعن 1637 لسنة 54ق – م نقض م – 36 – 176)
وإذا صدر القاضي حكما مبنيا على محضر جلسة لم يكتب بواسطة الكاتب أو لم يوقع منه كان هذا الحكم باطلا لابتنائه على إجراء باطل .
يلاحظ مما تقدم أنه يشترط التوقيع على محضر الجلسة من كل من القاضي وكاتب الجلسة ، بحيث إذا خلا من توقيع أحدهما كان باطلا متعلقا بالنظام العام ولا يقتصر الحكم على محاضر جلسات المرافعة في الدعوى وإنما يشمل كل إجراءات الدعوى كالمعاينة أو الاطلاع حيث تتم خارج المحكمة.
إذ يتعين أن يدون ذلك في حينه في محضر يحرره ويوقع عليه الكاتب مع القاضي ولا يغني عن توقيع المحضر على هذا النحو إقرار القاضي أو الكاتب بأن المحضر تحرر بخط الأخير في حضور الأول ، وإذا صدر الحكم مستندا الى محضر جلسة لم يكتب بواسطة كاتب الجلسة أو لم يوقع منه أو من القاضي كان الحكم مبنيا على إ جراء باطل بطلانا متعلقا بالنظام العام .
حالة تعدد الأوراق التي تحرر بها محضر التحقيق يكفي التوقيع على الورقة الأخيرة متى كانت متصلة بما سبقتها
وقد قضت محكمة النقض بأنه
عددت المادة 93 من قانون الإثبات الصادر بالقانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 البيانات التي يجب اشتمال محضر التحقيق عليها ولم تستلزم – وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة – ذكر اسم القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب واكتفت بتوقيع كل منهما على هذا المحضر وإذا حرر محضر التحقيق على أوراق منفصلة اشتملت الأخير منها على جزء من التحقيق واتصل بها القرار الصادر بإحالة الدعوى الى المرافعة ثم توقع عليها من القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب فإن التوقيع على هذه الورقة يعتبر توقيعا على محضر التحقيق والقرار مما يتحقق به غرض الشارع ف يما استعرضه من توقيع القاضي المنتدب للتحقيق وال كاتب على محضر التحقيق ولا يكون هذا المحضر باطلا.
(20/11/1985 طعن 495 سنة 52ق – م نقض م – 36 – 1022)
ولم يحدد القانون موعدا معينا لتوقيع محضر الجلسة وعلى ذلك يجوز توقيعه من القاضي والكاتب حتى صدور الحكم . أما إذا دفع الخصم ببطلان ما أثبت بمحضر الجلسة قبل توقيع الكاتب أو القاضي أو كلاهما فإنه يمتنع عليهما التوقيع عليه حتى ولو كانت الدعوى مازالت منظورة إذ يكون الخصم قد تعلق حقه بهذا الدفع .
(الدناصوري ص 201)
يعتبر رول القاضي مكملا لمحضر الجلسة في خصوص ما أثبت فيه وخلا منه محضر الجلسة مادام لا يتعارض معه
قضت محكمة النقض بأنه
ولئن كان محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية يعول عليها في إثبات ما يدور بالجلسة ويقع فيها وما يدلى به الخصوم من دفوع وأوجه دفاع ولا يقبل إنكار أو إثبات ما يخالف ما ورد به إلا بطريق الطعن عليه بالتزوير طبقا لنص المادة 11 من قانون الإثبات ، إلا أنه إذا أغفل محرره إثبات بيان أدلى له أثناء نظر الدعوى وأثبته القاضي بالرول الخاص به فإنه يعتبر مكملا لنحضر الجلسة في خصوص ما أثبت فيه وخلا منه محضر الجلسة مادام لا يتعارض معه .
لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة 10/5/1981 أمام محكمة أول درجة أنه تضمن إثبات حضور الأستاذ ……. عن الأستاذ …….. عن الطاعنة بتوكيل لم يدون كاتب الجلسة رقمه وترك لذلك مساحة فارغة أثبت بعدها طلب الوكيل تأجيل نظر الدعوى للاطلاع.
وإذ كان الثابت بالأوراق أن السادة قضاء محكمة أول درجة قد دون كل منهم في الرول الخاص به رقم هذا التوكيل مما مفاده أن خلو محضر الجلسة من إثبات هذا الرقم وتركه المساحة التي كان مفروضا أن يدون بها خالية كان من قبيل القصور عن ملاحقة ما يدلى به الخصوم ووكلائهم ، ولما كان هذا البيان الوارد برولات السادة القضاة لا يتعارض مع البيانات الأخرى الثابتة في محضر الجلسة المذكور فإن هذه الرولات تكون مكملة له إثبات سند وكالة الحاضر عن الطاعنة أمام محكمة أول درجة .
(30/11/1987 طعن 1796 سنة 53ق – م نقض م -38 – 1034 – 19/4/1980 – م نقض م – 31 – 1144 – 30/11/1987 طعن 1797 سنة 53ق)
إغفال إثبات قرار المحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة بمحضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان طالما أثبت هذا القرار بورقة الجلسة التي يحررها القاضي بخطه (الرول) وتحقق بمقتضاه وتنفيذا له استئناف السير في الخصومة بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى وذلك بدعوة طرفيها للاتصال بها بإعلان صحيح .
(27/4/1989 طعن 2545 سنة 56ق)
لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلا . (مادة 26 مرافعات).
وإذا كانت عبارة (أعوان القضاة) تمتد في مفهومها العام الى غير العاملين في الدولة كالمحامين وخبراء الجدول والمترجمين غير الحكوميين ووكلاء الديانة إلا أن النص لا يتناول غير العاملين في الدولة .
كما لا يسري بالنسبة الى العاملين في الدولة ممن خصهم المشرع بأحكام خاصة كالخبراء الحكوميين ، كما لا يسري كذلك على القضاة الذين يختصون بأحكام عدم الصلاحية والرد .
(محمد كمال عبد العزيز ص 116 ، مرجع سابق)
ولا يقصد النص مجرد الدعاوى إنما يقصد الإجراءات على وجه العموم ، كما إذا أعلن المحضر الغير بناء على طلب ممن ورد حصرهم في هذه المادة بمجرد إنذار أو تنبيه ، كما يشمل النص أيضا أعمال التنفيذ بالتحفظ .
(أحمد أبو الوفا )
يلاحظ أن القانون المدني قد نظم في المواد من 34 الى 37 كل ما يتعلق بالأصول والفروع ودرجات القرابة والمصاهرة وكيفية حسابها ، وزادها إيضاحا بمذكرته التفسيرية .
فتنص المادة (34) مدني على أنه
- تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباء .
- ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك .
وتنص المادة (35) مدني على أنه
- القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع .
- وقرابة الحواشي هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر .
وتنص المادة (36) مدني على أنه
يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات من الفرع للأصل المشترك ، ثم نزولا منه الى الفرع الآخر ، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة
وتنص المادة (37) مدني على أنه
أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الآخر .
البطلان المترتب على مخالفة الحظر الوارد في المادة لا يتعلق بالنظام العام فيتعين أن يتمسك به صاحب الشأن بالقيود الواردة في المادة 108 مرافعات
قضت محكمة النقض بأنه
أنه وإن كان يبين من مقارنة نصوص المواد 28 ، 313 ، 314 من قانون المرافعات السابق (تقابل المواد 26 – 146 – 147 من التقنين الحالي) أن المشرع قد رتب البطلان جزاء على مباشرة القاضي أو كاتب المحكمة عملا في الدعوى التي تربطه بأحد الخصوم فيها صلة قرابة الى الدرجة الرابعة .
إلا أنه غاير في التعبير بين الحالتين إذ بينما نص على وقوع البطلان بالنسبة لعمل القاضي أو قضائه ولو باتفاق الخصوم فإنه لم يورد نصا مماثلا لذلك بالنسبة لكاتب الجلسة ، وذلك على أساس أن البطلان الذي يشير إليه نص المادة 28 لا يتعلق بالنظام العام فلا تحكم به المحكمة إلا إذا تمسك به الخصم صاحب المصلحة ويسقط حقه في التمسك به إذا نزل عنه .
9/4/1974 طعن 121 سنة 39ق – م نقض م – 25 – 658
قارن الدكتور عبد العزيز بديوي في كتابه بحوث في قواعد المرافعات والقضاء في الإسلام ص 300 حيث يرى
أنه لا يترتب على مخالفة النص سوى المساءلة التأديبية.
في حين يرى الدكتور عاشور السيد مبروك في كتابه طرق تسليم الإعلان ص 23 أن
النص يتعلق بالنظام العام لتعلقه بأسس النظام القضائي وما يستهدفه من تجريد أعوان القضاء من الشبهات.
فقضت أيضا بأنه
لما كان ذلك الثابت من محاضر جلسات الدعوى أمام المحكمة الابتدائية أنه بعد أن قرر كاتب الجلسة أنه ابن عم المدعى – المطعون ضده – وافق الحاضر عن الطاعن الثاني على حضور هذا الكاتب بالجلسة كما قرر الحاضر مع الطاعن الثاني عدم اعتراضه على ذلك .
وكذلك فإنه لم يثبت أن باقي الطاعنين الذين قدموا مذكرة بدفاعهم في الدعوى – قد اعترضوا على أن يباشر هذا الكاتب عمله في الدعوى .
لما كان ما تقدم ، فإن الطاعنين يكونون قد نزلوا عن حقهم في التمسك ببطلان إجراءات نظر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية لهذا السبب مما لا يجيز لهم العودة الى التمسك به في الاستئناف ، وإذ انتهت محكمة الاستئناف الى عدم بطلان الحكم المستأنف استنادا الى نص المادة 28 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(9/4/1974 طعن 121 لسنة 39ق – م نقض م – 25 – 658)
هذا ويشترط في انطباق التحريم على الأشخاص الذين تناولتم النص أن يثبت لهم صفاتهم المستمدة من وظائفهم وقت مباشرة الأعمال المتعلقة بالدعاوى فإذا زلت عنهم هذه الصفة بعد مباشرة العمل الباطل المتعلق بالدعاوى فإن ذلك ليس من شأنه تصحيحه ، لأن العبرة هى بصفتهم وقت مباشرة الإجراء .
(عبد الرحيم عنبر ص 63)
ولا ينصرف حكم هذه المادة أيضا الى القضاة لأن حكمها فيما يتعلق بهم مما يدخل ويتصل بأحكام الرد ، وبعدم أهلية القاضي للقضاء . (مادة 494 مرافعات)
آثار البطلان في قانون المرافعات علي القضية المدنى
يترتب على الحكم ببطلان الإجراء اعتباره كأن لم يكن فيسقط وتسقط معه كل الإجراءات اللاحقة له متى كان هو أساسا لها وترتبت هى عليه (مادة 24/3)
كما يترتب على بطلان الإجراء زوال كافة الآثار القانونية المترتبة عليه فإذا قضى مثلا ببطلان صحيفة الدعوى استتبع ذلك بطلان جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك الحكم الصادر في الدعوى وإنما لا يمنع البطلان من تجديد الإجراء الذي حكم ببطلانه مصححا ما لم يكن الحق في إجرائه قد سقط لسبب من أسباب السقوط .
ويراعى أن الحكم ببطلان الإجراء لا يستتبع بطلان ما تقدم عليه من إجراءات ، كما لا تبطل الإجراءات المتأخرة عليه إذا كان لها كيان مستقل بذواتها ولن تكن معتمدة عليه (مادة 24 / 3) ، (مادة 159 من القانون الإيطالي) ولا تبطل الإجراءات المعاصرة له ما لم ترتبط له برباط لا يقبل التجزئة بسبب طبيعتها أو طبيعة موضوعها .
وتنص المادة 24 قانون المرافعات على أنه
إذا كان الإجراء باطلا وتوافرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحا باعتباره الإجراء الذي توافرت عناصره ، وإذا كان الإجراء باطلا في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل .
(أبو الوفا )
ومن المقرر أن البطلان يعتبر متعلقا بالنظام العام إذا نص المشرع على ذلك صراحة أو أوجب على القاضي الحكم به من تلقاء نفسه أو كان الإجراء معدوما أو كان يتصل بالمصالح العامة ولا يكفي لاعتباره متصلا بالنظام العام أن ينص على أنه يقع بقوة القانون لأن هذه العبارة لا تعني أكثر من حرمان القاضي من مكنة التقدير بحيث يتعين عليه القضاء بالبطلان .
ويجوز للدائن أن يتمسك ببطلان إجراء موجه الى مدينه على اعتبار أن حق التمسك بالبطلان لا يعد متعلقا بشخص المدين بشرط ألا يكون الحق المرفوعة به الدعوى متصلا بشخصه ، ومتى تم النزول عن البطلان صراحة أو ضمنا فإنه يقع باتا فلا يجوز العدول عنه أو التحلل من آثار فحضور الخصم للجلسة المحددة بعد الفصل في الادعاء بالتزوير يزيل مصلحته في التمسك بالبطلان لعدم إعلانه لهذه الجلسة وكذلك حضور خلف الخصم المتوفى يزيل مصلحته في التمسك بالبطلان لعدم القضاء بالانقطاع .
كذلك من المقرر أن القاضي لا يحكم بالبطلان على أساس أنه منصوص عليه في التشريع إلا إذا تقرر البطلان بلفظه أى يقول النص (وإلا كان الإجراء باطلا) مثلا ولا يعمل بهذه القاعدة المتحدثة إلا بالنسبة لقانون المرافعات الجديد والقوانين التالية عليه فقد أما القوانين السابقة عليه والتي تعتمد على تقرير البطلان بعبارة ناهية أو نافية إعمالا للمادة 25 من قانون المرافعات القديم – هذه القوانين يجب احترام حالات البطلان فيها ولو بعبارة ناهية أو نافية .
كلمة للسادة القضاة بشأن البطلان
نهيب بالسادة القضاة لحسن تحقيق العدالة التأنى في نظر الدعاوى واعطاء الدفاع حقه في اثبات الغش والبطلان حفاظا علي حقوق المتقاضي المظلوم ، فالعجلة في انهاء الدعاوى طريق محفوف بالمخاطر ، والتأنى لن يضير العدالة ، فنرجو الامتثال لكافة أوجه الدفاع والطلبات لتحقيق القضية واغلاقها وفقا للقانون ليصدر في الأخير حكما عادلا مستوفيا للشروط والقانون محققا العدالة .
ختاما: نؤكد أن الغش في الاجراء يؤدى الى البطلان كما نص قانون المرافعات ، ومن ثم الالتزام بقانون المرافعات، وتجنب الغش والبطلان، مسائل هامة لنجاح دعواك المدنية ، ويساعد على تحقيق العدالة وحماية حقوق الجميع، فان أردت الغش لعدم علم خصمك بدعواك فلن تفلح في الوصول الى مأربك ، وفي الأخير أنصح زملائى المحامين بقراءة وفهم نصوص قانون المرافعات جيدا لأهميته في انهاء الدعوي المدنى قبل الخوض في موضوعها.
- انتهي البحث القانوني (الغش والبطلان الإجرائي: في قانون المرافعات) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
تاريخ النشر: 2024-08-01
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2024/08/الغش-والبطلان-الإجرائي-قانون-المرافع.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2024-08-01.