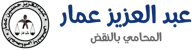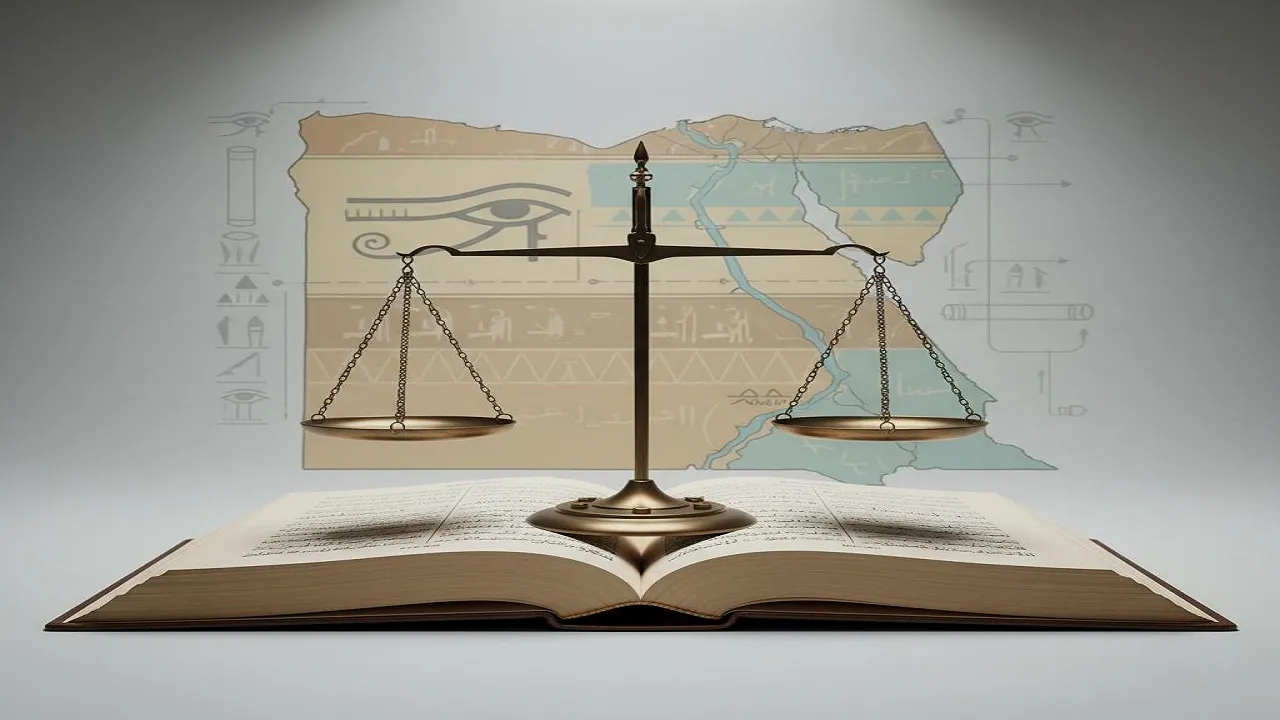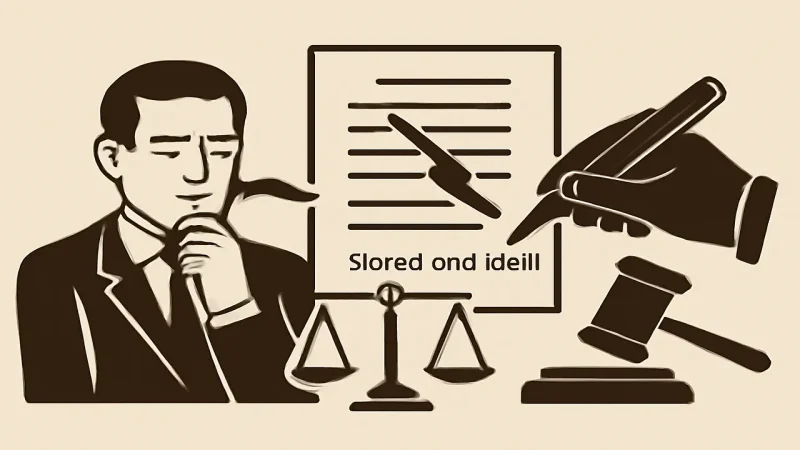📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
بحث شامل حول “تنازع القوانين من حيث المكان” وكيف يحدد القانون المصري الواجب التطبيق في النزاعات ذات العنصر الأجنبي وفقا لقواعد الإسناد والمادة 10 قانون مدني.
تنازع القوانين من حيث المكان: كيف يحدد القانون المصري الواجب التطبيق؟
تنازع القوانين من حيث المكان هو أحد موضوعات القانون الدولي الخاص التي تثار عندما تتضمن العلاقة القانونية عنصرًا أجنبيًا.
وفي هذا السياق، يُعد القانون المصري مرجعًا أساسيًا في تكييف هذه العلاقات وتحديد القانون الواجب تطبيقه .
ويهدف هذا البحث إلى شرح كيفية تطبيق قواعد الإسناد لتحديد القانون الذي يختص بالنزاع الدولي، ويفصل في التكييف الذي يجب أن يتبعه القاضي عند نظر النزاع.
- ما هو مفهوم تنازع القوانين من حيث المكان؟
- كيف تُحدد المحكمة القانون الواجب تطبيقه؟
- ما هي القواعد القانونية التي تحكم هذا النوع من المنازعات؟
تعريف مفهوم تنازع القوانين قانونا
تنازع القوانين يُقصد به الحالة التي تتزاحم فيها أكثر من قاعدة قانونية وطنية أو أجنبية لحكم علاقة قانونية تحتوي على عنصراً أجنبياً.
ويتحقق هذا التنازع – عادة – في سياق معاملات مدنية أو أسرية أو عقارية عندما تُثار مسألة أي قانون يجب أن يحكم العلاقة محل النزاع.
هذا ويعرف القانون الدولي الخاص المصري تنازع القوانين بأنه:
مجموعة قواعد (قواعد الإسناد) ترشد القاضي للقانون الواجب التطبيق عندما تحتوي العلاقة القانونية على عنصر أجنبي، سواء كان الأشخاص، أو موضوع العلاقة، أو مكان إبرامها أو تنفيذها.
لذلك، المادة 10 مدني تنص أن:
“القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين”.
ومن ثم، التكييف القانوني يُعد إجراءً جوهريًا حاسمًا للاستهداء إلى قاعدة الإسناد الصحيحة وتطبيق النظام القضائي الأنسب للنزاع.
مفهوم المصطلح و الفكرة القانونية:
تنازع القوانين من حيث المكان هو الموضوع الذي يختص بتحديد القانون الذي ينطبق على العلاقات القانونية التي تشمل عناصر دولية، مثل الأشخاص أو المكان أو الموضوع الذي تم فيه التصرف.
وتستخدم قواعد الإسناد لتحديد القانون الواجب تطبيقه على العلاقة القانونية التي تحتوي على عنصر أجنبي.
لذلك، القانون المصري يعتبر المرجع لتكييف العلاقات القانونية المتنازع عليها وفقًا للمادة 10 من القانون المدني المصري.
النص القانوني وتفسيره
تنص المادة 10 من القانون المدني المصري على أنه يجب على القاضي الرجوع إلى القانون المصري لتكييف العلاقات القانونية التي تتضمن عنصرًا أجنبيًا.
ويعتبر ذلك ضروريًا لتحديد القانون الواجب التطبيق بعد تحديد نوع العلاقة القانونية في النزاع.
تفسير المادة 10 مدني:
القاعدة العامة تقتضي أن القاضي يتبع القانون المصري لتكييف العلاقات، ما يضمن تماشيًا مع الشريعة الإسلامية في حال كان النزاع يتعلق بالأحوال الشخصية.
تنص المادة 10 من القانون المدني المصري على أن القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات القانونية حال تنازع القوانين.
أي عند وجود عنصر أجنبي بنزاع مطروح أمام المحكمة المصرية، يجب أن يرجع القاضي إلى القانون المصري لتكييف طبيعة العلاقة، قبل البحث عن القانون الواجب التطبيق بالاستناد لقواعد الإسناد ذاتها.
والمقصود أن تكييف العلاقة القانونية (هل هي ميراث؟ زواج؟ وصية؟ عقار؟) يخضع للمبادئ العامة السائدة في القانون المصري – وليس فقط لنصوص التشريع، بل يجب الاسترشاد بروح التشريع وأحكام القضاء المصري.
وبعد التكييف الأولي، يتم تحديد فئة العلاقة (مثل علاقة عينية، التزامات، أحوال شخصية)، ثم تطبق قاعدة الإسناد التي تحيل إلى القانون المختص بحل النزاع (وطني أو أجنبي).
و استثناءً، في تحديد صفة العقار والمنقول، يجب الأخذ باعتبارات عملية بحسب الفقه القضائي.
الأحكام الفقهية والتشريعية المتصلة في الدول العربية
- المادة تقابل نصوصًا مماثلة في بعض البلدان العربية: مادة 10 ليبي، 11 سوري، 17 عراقي، 13 سوداني.
- والفقه المصري يؤكد إلزام المحكمة بالرجوع إلى القانون المصري بنظرة شمولية، دون الاقتصار على توزيع ولاية القضاء أو نظام واحد.
التطبيقات القضائية والسوابق العملية
أمثلة من السوابق القضائية:
- حالة الطعن على بيع من المورث: عندما يتصدى القاضي لمثل هذه المنازعات، يُرجع تكييف العلاقة القانونية إلى القانون المصري ثم يُطبق القانون الواجب بناءً على قاعدة الإسناد.
- النزاعات المتعلقة بالأموال والمنقولات: تم تطبيق القاعدة العامة التي تفيد بأن تكييف العلاقة يتم وفقًا للقانون المصري، مع تحديد القانون الواجب تطبيقه بناءً على القاعدة الخاصة بالأموال.
لذلك، المحاكم المصرية، خاصة محكمة النقض، طبقت قاعدة التكييف وفق القانون المصري في عديد النزاعات المدنية والشخصية ذات العنصر الأجنبي.
وأصدرت أحكامًا تؤكد:
- المرجع في تحديد ما إذا كانت المسألة من مسائل الأحوال الشخصية هو القانون المصري وفقا للمادة 10 مدني.
- لا يجوز للقاضي أن يحيد عن التشريع الوطني عند أداء مهمة التكييف، حتى لو اختلف نوع العلاقة القانونية عما هو مألوف.
- يحق للمحكمة الاستئناس بنصوص القانون الأجنبي، لكن التكييف النهائي يظل وفق المبادئ العامة للقانون المصري.
أمثلة عملية:
- نزاع حول ميراث بين مصري وأجنبي: يتم تكييف العلاقة وفق القانون المصري لتحديد النظام القانوني السائد، ثم تطبق قاعدة الإسناد لاختيار القانون الواجب التطبيق.
- دعوى تتعلق بعقار في الخارج مملوك لمصري وجنسيته أوروبية: تكييف العلاقة يكون أولاً بحسب القانون المصري؛ وتحديد صفة المال يخضع لقانون الجهة الموجود بها المال.
- منازعات التزامات دولية: التكييف يتم وفقاً لمبادئ القانون المصري، وقد تؤخذ أحكام القانون الأجنبي بالاعتبار كمرجعية إيضاحية فقط.
جدول بأهم الأسئلة الشائعة
| السؤال | الإجابة المختصرة |
|---|---|
| هل يمكن للقاضي تطبيق القانون الأجنبي؟ | نعم، في حال كان القانون الأجنبي هو الواجب التطبيق وفقًا لقاعدة الإسناد. |
| ما هو دور القاضي في تفسير القانون الأجنبي؟ | يُعتبر القاضي صاحب السلطة في تفسير القانون الأجنبي باستخدام وسائل متعددة لتحديد مضمونه بشكل دقيق. |
| ما هو المقصود بتنازع القوانين؟ | تزاحم بين قوانين وطنية وأجنبية لحكم علاقة بها عنصر أجنبي |
| كيف يحدد القاضي القانون الواجب التطبيق؟ | بالتكييف الأولي حسب القانون المصري، ثم تطبيق قاعدة الإسناد المختصة |
| ما أهمية المادة 10 مدني في قضايا التنازع؟ | تضمن الرجوع إلى القانون المصري في تحديد طبيعة العلاقة القانونية |
| هل يجوز للقاضي الاستعانة بنصوص القانون الأجنبي؟ | يجوز للاستئناس فقط، لكن المرجع النهائي هو المبادئ العامة للقانون المصري |
| ماذا يفعل القاضي إذا تعذر كشف مضمون القانون الأجنبي؟ | يطبق القانون الأكثر ارتباطًا أو قانون القاضي نفسه وفق الحالة |
| هل للأحكام القضائية السابقة تأثير على تفسير التنازع؟ | نعم، تسهم أحكام محكمة النقض والمحاكم العليا في ترسيخ المفاهيم وطرق التكييف |
كيفية تحديد القانون الواجب التطبيق في قضايا تنازع القوانين من حيث المكان في القانون المصري
مقدمة تعريفية:【تنازع القوانين – القانون المصري – المادة 10 مدني】
نتعرف على أحكام تنازع القوانين من حيث المكان في القانون المصري وفق المادة 10 مدني، وكيف تحدد المحكمة القانون الواجب التطبيق بالتفصيل عند【تنازع القوانين، القانون المصري】.
حيث تواجه المحاكم المصرية يوميًا قضايا تشتمل على «تنازع القوانين من حيث المكان»؛ أي عندما تطرح نزاعات تحوي عنصراً أجنبياً وتُثار مسألة القانون الواجب التطبيق【تنازع القوانين، القانون المصري】.
و يستند القاضي المصري إلى المادة 10 من القانون المدني التي تعتبر المرجع في تكييف العلاقات القانونية وتحديد النظام القانوني السائد.
وهو ما يثير تساؤلات عديدة عن كيفية تطبيق هذه المادة، وضوابط التكييف القانوني، وجوانب الإثبات، والسوابق القضائية ذات الصلة【تنازع القوانين، المادة 10 مدني】.
ومن ثم، في هذا البحث، نعرض شرحًا تفصيليًا للمفاهيم الرئيسية، الحلول القضائية، وأكثر الأسئلة شيوعًا حول الموضوع مع الإجابات، مع إبراز تطبيقات محكمة النقض وأهمية الرجوع إلى قانون القاضي.
النص التشريعي (المادة 10):
القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات فى قضية تتنازع فيها القوانين، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها:
النصوص العربية المقابلة:
هذه المادة مقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية: مادة 10 ليبى و11 سورى و 17 عراقى و 13 سودانى.
الأعمال التحضيرية للمادة 10 مدني
تقضى الفقرة الأولى من هذه المادة بوجوب رجوع المحاكم إلى القانون المصرى فى تكييف الروابط القانونية، تمشيا مع الراى الذى كاد ينعقد عليه الاجماع فى الوقت الحاضر.
ويراعى من ناحية ان للنص على هذا الحل أهمية خاصة فى مصر، بسبب توزيع ولاية القضاء بين محاكم مختلفة، وينبغى ان يفهم من وجوب رجوع المحاكم المصرية إلى قانونها فى مسائل التكييف الزامها بالرجوع إلى القانون المصرى فى جملته،
وبما يتضمن من قواعد تتعلق بالأشخاص أو بالاموال ايا كان مصدر هذه القواعد دون ان تقتصر على الأحكام التى تختص بتطبيقها وفقا لتوزيع ولاية القضاء.
ويراعى من ناحية اخرى ان تطبيق القانون المصرى بوصفة قانونا للقاضى فى مسائل التكييف لا يتناول الا تحديد طبيعة العلاقات فى النزاع المطروح لادخالها فى نطاق طائفة من طرائف النظم القانونية التى تعين لها قواعد الإسناد إختصاصا تشريعيا معينا.
كطائفة النظم الخاصة بشكل التصرفات أو بحالة الأشخاص أو بالمواريث والوصايا أو بمركز الاموال، ومتى تم هذا التحديد، انتهت مهمة قانون القاضى.
اذ يتعين القانون الواجب تطبيقه ولا يكون للقاضى الا ان يعمل أحكام هذا القانون .
على ان الفقرة الثانية قد استثنت من حكم القاعدة العامة حالة تعلق التكييف بتعيين صفة العقار أو المنقول، فجعلت المرجع فى ذلك بإعتبارات عملية استرعت انتباه الفقه والقضاء
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون – الجزء 1 – ص 233 وما بعدها
تنازع القوانين من حيث المكان
1 – ان علاقات القانون الدولى الخاص لا تتسم بطابع سيادة الدولة أو سلطانها، الا ما كان منها ذا طابع امر اوناه، بسبب تعلقه بمصلحة عليا، وكانت لذلك متعلقة بالنظام العام أو الاداب.
ولذا يمكن القول بصفة عامة انه يمكن ان يسرى فى علاقات القانون الخاص مبدأ إمتداد القوانين، مادام انه لا يخل بسيادة الدولة ان يسمح بأن يطبق فى اقليمها قانونى اجنبى لحكم علاقة من علاقات القانون الخاص.
ولذا يوجد فى قوانين جميع الدول قواعد تنظيم تطبيق القوانين الاجنبية فى اقليمها، وهذه تسمى قواعد القانون الدولى الخاص، وهى قواعد لا تنظم العلاقات القانونية،
بل تبين القانون الذى يجب تطبيقه على العلاقة القانونية التى يوجد فيها عنصر اجنبى، اهو القانون الوطنى ام القانون الاجنبى.
وفيما يتعلق بقانوننا نجد هذه القواعد فى القانون المدنى فى المواد من 10 إلى 28 – وتصدر هذه القواعد عن معايير تختلف بحسب طبيعة العلاقة القانونية التى يتوافر فيها عنصر اجنبى
المدخل لدراسة العلوم القانونية- الدكتور عبد الحي حجازي- ص433
2 – إذا كان النزاع ذا صبغة اجنبية، وكان القانون الواجب التطبيق هو قانون اجنبى، فإن المشرع المصرى ترك لقاعدة الإسناد تحديده.
وقد وضع المشرع القواعد الأساسية فى المواد من 10 إلى 28 مدنى، وكانت أولى هذه القواعد الأساسية هى القاعدة التى لها الصدارة فى فقه القانون الدولى الخاص.
وهى مسألة تكييف بالعلاقة القانونية محل النزاع، وهى مسألة أولية يقتضى على القاضى الفصل فيها قبل النظر فى القانون الواجب التطبيق.
ذلك انه يقتضى عند قيام نزاع فيه عنصر اجنبى، ان يحدد القاضى أولا طبيعة العلاقة القانونية المطروحة أمامه للفصل فيها، وتحديد العلاقة القانونية من الأهمية بمكان.
حتى يستطيع القاضى على ضوء هذا التكييف الاهتداء إلى قاعدة الإسناد المقررة فى القانون-ولقد ثار الخلاف فى الفقه حول القانون الذى يخضع له تحديد العلاقة القانونية عند تنازع القوانين.
وإستقر القانون المصرى على ارجح الاراء فى الفقه الحديث، وهو اخضاع التكييف أو تحديد العلاقة القانونية فى النزاع المطروح، لقانون القاضى.
اى للقانون المصرى، لهذا جاء نص المادة 10 من القانون المدنى الحالى بأن القانون المصرى هو المرجح فى تكييف العلاقات فى قضية تتنازع فيه القوانين لمعرفة القانون الواجب التطبيق
المقصود بالأحوال الشخصية – مقال – المستشار أحمد خيرت – مجلة القضاه – العدد 8 – سبتمبر سنة 1923 – ص 61 وما بعدها
3 – قد تكون العلاقة المعروضة على القاضى اما وطنية، واما اجنبية أو ذات عنصر اجنبى، فإن كانت وطنية، وجب تكييفها وفقا للنظام القانونى الوطنى، اى وفقا للقانون المصرى فى مجموعه.
ولا شك ان الشريعة المسيحية والموسوية تدخلان فى جملة النظام القانونى المصرى، وان كان البعض يرى وجوب جريان التكييف فى كل الأحوال وفق الشريعة الإسلامية،
وذلك بحسبانها النظام الغالب فى نظامنا القانون المركب، وبحسبانها النظام صاحب الولاية العامة بالنسبة لجميع المصريين
(الأحوال الشخصية لغير المسلمين – للدكتور توفيق فرج – ص 14 وما بعدها)
وان كانت العلاقة ذات عنصر اجنبى، أو اجنبية، فالقانون المصرى هو المرجح فى تكييف هذه العلاقة طبقا للمادة 10 من القانون المدنى.
وذلك بوصف ان القانون المصرى هو قانون القاضى الذى يفصل فى النزاع، وقد اتبع مشرعنا فى ذلك الرأى الغالب فى فقه القانون الدولى الخاص، وما هو عليه الحال فى معظم التشريعات الاجنبية، وهو ايضا ما ذهبت إليه محكمة النقض.
منازعات الأحوال الشخصية – مقال – للأستاذ نصيف زكي – المحاماه – السنة 36 – العدد 9 – ص 147 وما بعدها، والعدد 10 – ص 1601 وما بعدها، والسنة 32 – العدد 1 – ص 103 وما بعدها
4 – يقصد بالقانون المصرى فى معنى المادة 10 من القانون المدنى المصرى، فى جملته، بما تتضمن من قواعد تتعلق بالأشخاص أو الأحوال أو الإلتزامات، وايا كان مصدر هذه القواعد.
وبعبارة اخرى لا يقتصر القاضى عند تحديده العلاقات القانونية، ان يبحث عن نوع تلك العلاقة وفقا لتوزيع ولاية القضاء، بل له ان يبحثها فى القانون المدنى.
كما ان له ان يرجع إلى الشريعة الإسلامية أو القوانين الخاصة المنظمة للميراث أو الوصية و… الخ، وله ايضا تكييف تلك العلاقة وفقا لروح التشريع المصرى وإتجاه القضاء فى الجملة وفقا لثقافته القانونية
(يراجع ايضا: مقال: الأحوال الشخصية للاجانب ومدى خضوعها لأحكام الشريعة للأستاذ سيف النصرزكى – مجلة التشريع والقضاء – السنة 2 – العدد 5 – ص25 وما بعدها).
وليس للقاضى ان يحيد عن تشريعه عند قيامه بهذه المهمة مهما دقت العلاقة القانونية وإختلفت طبيعتها عما هو مألوف لديه.
اذ يمكنه بمراجعة وقائع الدعوى وعناصرها المادية ان ينسب تلك الوقائع إلى نوع معين من النظم القانونية المعروفة فى قانونه.
وهذه العملية عبر عنها البعض:
(بوضع القماش القانونى الاجنبى فى دولاب النظم الوطنية).
على ان تطبيق القانون المصرى بوصفه قانون القاضى فى مسائل التكييف لا يتناوله الا تحديد طبيعة العلاقة فى النزاع المطروح لادخالها فى نطاق طائفة من طوائف النظم القانونية التى تعين لها قواعد الإسناد إختصاصا تشريعيا معينا.
كطائفة النظم الخاصة بشكل التصرفات أو بحالة الأشخاص أو بأهليتهم أو بالمواريث أو الوصايا أو بمركز الاموال، ومتى تم هذه التحديد انتهت مهمة القاضى.
اذ يتعين عندئذ القانون الواجب التطبيق، ويتحتم على القاضى ان يعمل بأحكام هذا القانون المادة 10 مدنى لتعيين الحدود التى يقف عندها إختصاص قانون القاضى فى التكليف
تكييف العلاقة القانونية وأهميته في مسائل ومنازعات الأحوال الشخصية – مقال المستشار حسن رفعت – المحاماه – السنة 31 – العدد 4 – ص 848 وما بعدها
التعريف بالقانون الدولي الخاص وطبيعة قواعده
العلاقات التي تقوم بين الأشخاص إما أن تكون علاقات وطنية بحتة بجميع عناصرها، وإما أن تكون أجنبية في عنصر أو أكثر من عناصرها.
فإذا باع أحد المصريين مثلا عقاره الموجود في مصر لمصري آخر، فإن العلاقة تكون علاقة وطنية بحتة في كل عناصرها.
وعناصر العلاقة هى:
الأشخاص والموضوع والمكان الذي قامت فيه العلاقة، فالأشخاص في هذه الحالة مصريون، وموضوع العلاقة وهو العقار موجود في مصر، والمكان الذي قامت فيه العلاقة هو مصر.
وهنا لا تدخل قواعد القانون الدولي الخاص، لأن جميع عناصر العلاقة وطنية .
أما إذا كان أحد العناصر السابقة أجنبيا، بأن كان أحد الأشخاص أجنبيا، أو أن العلاقة قامت في بلد أجنبي، أو أن موضوع العلاقة كان موجودا في الخارج، فإن قواعد القانون الدولي الخاص تتدخل.
فتبين ما هى المحكمة المختصة، هل هى المحكمة الوطنية أو المحكمة الأجنبية، كما تبين ما هو القانون الذي يحكم العلاقة، هل هو القانون الأجنبي أم القانون الوطني.
ومن هذا يتبين أن القانون الدولي الخاص هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات ذات العنصر الأجنبي بين الأفراد، وذلك من حيث بيان المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق،
فالقواعد التي يحتوي عليها القانون الدولي الخاص لا تنظم العلاقات ذات العنصر الأجنبي بصورة مباشرة، ولكن وظيفة هذه القواعد، بعد أن تحدد المحكمة المختصة، هى بيان القانون الواجب التطبيق على هذه العلاقات ذات العنصر الأجنبي.
وقد يكون القانون الواجب التطبيق هو القانون الوطني أو القانون الأجنبي، وبمعنى آخر، إن قواعد القانون الدولي إذا كانت تبين القانون الواجب تطبيقه وهل هو القانون المصري أم القانون الأجنبي.
فإنها لا تمس موضوع النزاع الأصلي، لأن الفصل في هذا الموضوع، لا يكون إلا بتطبيق القانون الموضوعي الذي تحيلنا إليه قواعد القانون الدولي الخاص.
ومن هذا نستطيع أن نتبين أن موضوع القانون الدولي الخاص هو بيان اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعاوى التي ترفع بشأن العلاقات القانونية الخاصة ذات العنصر الأجنبي، وبيان القانون الواجب تطبيقه على هذه العلاقات،
وهذا هو الموضوع الرئيسي للقانون الدولي الخاص.
ولكن البعض من الفقهاء يرون إدخال موضوعات أخرى في نطاق القانون الدولي الخاص، هذه الموضوعات الأخرى هى القواعد التي تنظم الجنسية والقواعد الخاصة بالموطن وبمركز الأجانب.
وعلى هذا فإن القواعد التي تنظم متى تثبت للشخص جنسية البلد تعد من قواعد القانون الدولي الخاص، مع أنها تنظم علاقة الفرد بالدولة من حيث حقه في التمتع بجنسيتها، وبما أنها علاقة بين الفرد والدولة.
فهى في أصلها من علاقات القانون العام، وكذلك الحال بالنسبة للقواعد الأخرى التي تنظم توطن الأجانب في الدولة وتلك التي تبين مركزهم من حيث تمتعهم بالحقوق وتحملهم بالواجبات في الدولة.
وهذه القواعد هى الأخرى تدخل أصلا في نطاق القانون العام، لأنها تنظم علاقة الدولة بالأجانب، ويراعى أن هذا الفرع من فروع القانون قد سمى بالقانون (الدولي) نظرا لأن أحكامه تطبق بالنسبة للعلاقات التي كون فيها عنصر أجنبي أو أكثر.
أى أن العلاقة تكون دولية بالنسبة الى عنصر من عناصرها، كما سمى (بالخاص) لأنه يطبق بصدد المنازعات التي تهم الأفراد،
وبذلك يتميز عن القانون الدولي العام الذي ينظم العلاقات بين الدول، والواقع أن قواعد القانون الدولي الخاص بصفة عامة تعد قواعد مختلطة .
فالقواعد التي تتعلق بالجنسية والموطن ومركز الأجانب تدخل في نطاق القانون العام، لأنها تنظم العلاقات بين الدولة والأفراد.
أما القواعد الأخرى الخاصة ببيان الجهة المختصة والقانون الواجب التطبيق، وهى ما تسمى بقواعد تنازع القوانين، فهى تدخل في نطاق القانون الخاص .
(توفيق فرج، السنهوري، غانم، المراجع المشار إليها)
قواعد الإسناد وطبيعتها
قواعد الإسناد هى ” القواعد القانونية التي ترشد القاضي الى القانون الواجب التطبيق على المراكز القانونية ذات العنصر الأجنبي “،
فهى قواعد تواجه المراكز أو العلاقات الداخلية فيما يسمى بالحياة الخاصة الدولية
(شمس الدين الوكيل، الموجز في الجنسية ومركز الأجانب ص7)
وقواعد الإسناد على هذا النحو هى قواعد يضعها المشرع الوطني لاختيار أكثر القوانين المتزاحمة ملائمة لحكم العلاقة الخاصة المتضمنة عنصرا أجنبيا، وأكثرها إيفاء بمقتضيات العدالة من وجهة نظره.
فقواعد الإسناد تهدف إذن الى وضع أكثر الحلول مناسبة، من وجهة نظر المشرع الوطني، لحكم العلاقات الخاصة الدولية
(هشام صادق، مرجع سابق ص3، 7)
ومن هنا يبدو لنا أن القول بأن مهمة قواعد الإسناد هى فض مشكلة (تنازع القوانين) يتضمن قدرا كبيرا من التجوز، فليس هناك (تنازعا حقيقيا بين أكثر من قانون يدعى كل أنه صاحب سند شرعي في حكم المنازعة) .
ولا يعقل أن يكون هذا هو ما قصده الفقيه الهولندي Huber حينما ابتكر تسمية (تنازع القوانين) إذ من المعلوم أن المدرسة الهولندية قد أقامت تطبيق القانون الأجنبي على فكرة المجاملة الدولية.
ولا شك أن إرجاع تطبيق القانون الأجنبي الى فكرة المجاملة يتنافى في ذاته مع القول بأن هناك ثمة تنازعا حقيقيا بين القوانين لحكم العلاقات الخاصة الدولية.
ولا يستقيم تعبير (تنازع القوانين) إلا إذا سايرنا الاتجاهات الفقهية التي ظنت أن قواعد الإسناد تقوم بتوزيع الاختصاصات القانونية المختلفة.
وتحدد نطاق تطبيق القوانين المتنازعة لحكم المراكز القانونية المتضمنة عنصرا أجنبيا، ولا شك أن مثل هذه الاتجاهات تقوم على وهم خاطئ.
إذ لا يتصور بحال من الأحوال أن مهمة قواعد الإسناد الفرنسية مثلا هى توزيع الاختصاص التشريعي للقوانين الأجنبية المختلفة، فالقانون الدولي الخاص لا يقوم بتوزيع الاختصاص بين الدول.
وإنما ينحصر موضوعه المباشر – وفقا لما انتهى إليه الفقه الحديث – في حكم العلاقات ذات العنصر الأجنبي (بحيث تنصب قواعده على العلاقة التي تبحث عن حل قانوني لا على القانون الذي يريد أن يبسط سلطانه ليحكم تلك العلاقة “
(د/ أحمد القشيري، نطاق وطبيعة القانون المدني الخاص، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية 1968، ص122)
وإذا كنا قد أبرزنا ما يتضمنه اصطلاح تنازع القوانين من تجوز، فإن حرصنا مع ذلك على استخدامه لا يعدو أن يكون تمشيا مع اتجاه الفقه الغالب في القانون الدولي الخاص.
والذي درج على استخدامه دون أن يقصد ما قد يتضمنه الاصطلاح من معنى التسليم بوجود ثمة تنازع حقيقي بين القوانين المتزاحمة لحكم العلاقات الخاصة الدولية
(عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني 1955 رقم 3) .
طبيعة قواعد الإسناد
يختلف الفقه حول طبيعة قواعد الإسناد ومدى انتمائها الى كل من فرعي القانون العام والقانون الخاص، ويتجه فريق من الشراح الى اعتبار قواعد الإسناد جزءا من القانون العام.
وأساس هذا الرأى أن مهمة هذه القواعد هى توزيع الاختصاص التشريعية بين الدول، وقد مضت الإشارة الى ما يتضمنه هذا النظر من قصور .
فقاعدة الإسناد لا تضع حلا للتنازع بوصفه تنازعا بين السيادات، وإنما تنحصر مهمتها في وضع الحل الملائم للعلاقة الخاصة الدولية محل النزاع.
ولهذا يميل الفقه الغالب الى القول بأن قواعد الإسناد تنتمي الى القانون الخاص، لأنها تحكم علاقات خاصة وإن تضمنت عنصرا أجنبيا.
فإعمال قواعد الإسناد لا يعرض في الأصل، إلا بمناسبة علاقات القانون الخاص، مثل الروابط التعاقدية ومسائل الزواج والميراث والوصايا …. الخ.
أى العلاقات التي لا تكون الدولة موضوعا لها أو طرفا فيها بوصفها صاحبة السيادة، ومادامت الغاية من قواعد الإسناد هى تنظيم علاقات القانون الخاص التي تنطوي على عنصر أجنبي، ببيان القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق على هذه العلاقات.
فإن مؤدى ذلك أن تعتبر تلك القواعد شقا مكملا لقواعد القانون الخاص الموضوعية .
(د / محمد كمال فهمي، مرجع سابق ص 56)
أما قيام قواعد الإسناد بتحديد نطاق تطبيق القانون من حيث المكان فهو أمر غير مقصود في ذاته، بل هو نتيجة طبيعية لتعيين القانون الدولي الذي يحكم النزاع.
وبعبارة أخرى فإن قيام قواعد القانون الدولي الخاص بتحديد القانون الواجب التطبيق، لا يعدو أن يكون مجرد وسيلة تستخدمها هذه القواعد للتوصل الى الهدف الذي تسعى إليه، وهو تنظيم الحياة الخاصة الدولية
(فؤاد رياض، الوسيط في القانون الدولي الخاص، ص 110، محمد كمال فهمي ص 56)
ومهما كان الأمر، فإن جانبا من الفقه الحديث قد تصور مع ذلك قيام تنازع القوانين في مجال علاقات القانون العام، على الأقل في بعض الفروض.
وهو اتجاه أملته بالدرجة الأولى دقة التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص وصعوبة التمييز بينهما من جهة،
وما أظهره العمل من صور مختلفة لحالات تطبيق القانون العام الأجنبي أمام القضاء الوطني من جهة أخرى، ولا شك أم مراعاة هذا الاتجاه الأخير قد يصعب معه التسليم المطلق باعتبار قواعد الإسناد جزءا من القانون الخاص.
ودون أن نتطرق الآن لمناقشة هذا الاتجاه، والأخذ بالرأى السالف قد يقتضي القول بالطبيعة المختلطة لقواعد الإسناد، وذلك على أساس اتصالها المزدوج بكل من القانون الخاص من ناحية، والقانون العام من ناحية أخرى.
(هشام صادق، مرجع سابق، فؤاد رياض، مرجع سابق، محمد كمال فهمي، مرجع سابق).
كيفية تطبيق القانون الأجنبي في النظام القانوني المصري
شروط وآلية تطبيق القانون الأجنبي في مصر
على القاضي تطبيق القانون الأجنبي الذي تشير بتطبيقه قواعد الإسناد:
إذا خلص القاضي من تكييفه للعلاقة القانونية المعروضة عليه، ورأى أن القانون الأجنبي هو واجب التطبيق، تعين عليه تطبيقه دون أن يتمسك الخصوم بذلك.
ويراعى من ناحية أخرى أن تطبيق القانون المصري بوصفه قانونا للقاضي في مسائل التكييف لا يتنازل إلا تحديد طبيعة العلاقات في النزاع المطروح لإدخالها في نطاق طائفة (نوع) من طوائف النظم القانونية التي تعين لها قواعد الإسناد اختصاصا تشريعيا معينا .
كطائفة النظم الخاصة بشكل التصرفات أو بحالة الأشخاص أو بالمواريث والوصايا أو بمركز الأموال، ومتى تم هذا التحديد انتهت مهمة قانون القاضي .
إذ يتعين القانون الواجب تطبيقه ولا يكون للقاضي إلا أن يعمل بأحكام هذا القانون وقد استرشد المشروع في صياغة القاعدة الواردة في الفقرة الأولى بالمادة 6 من تقنين بوستامنتي والمادة 7 من المجموعة الأمريكية الخاصة بتنازع القوانين .
(مجموعة الأعمال التحضيرية ج1 ص335 وما بعدها)
طرق وأساليب إثبات القانون الأجنبي في المحكمة المصرية
عدم التقيد بقواعد الإثبات القضائي التي نظمها المشرع لإثبات الوقائع، فكل من المشرع المصري أو الفرنسي لم ينص صراحة على الطرق الجائز الالتجاء إليها للبحث عن مضمون القانون الأجنبي.
ولذا كان الأصل هو حق القاضي في الالتجاء إلى كافة وسائل العلم بالقانون الأجنبي التي يراها الأصلح للوصول إلى الحقيقة الموضوعية فهو لا يتقيد سلفا بالطرق التي نص عليها المشرع لإثبات الوقائع.
وإن جاز له الاستئناس بها إذا تبين سلامتها للكشف عن مضمون القانون الأجنبي، ولهذا السبب فقد استقر الفقه والقضاء في فرنسا على استبعاد الاعتراف و اليمين كوسائل لإثبات القانون الأجنبي.
رغم أنها من أكثر الطرق استخداما لإثبات الوقائع، فلا يجوز للقاضي أن يأخذ باعتراف الخصوم واتفاقهم على مضمون معين للقانون الأجنبي.
لأن من واجبه تطبيق القانون الأجنبي الكائن فعلا في الخارج، لا أن يطبق قانونا وهميا فرضته عليه إرادة الخصوم أو مصلحتهم في الدعوى.
وعلى العكس فقد أقر كل من القضاء الفرنسي والمصري إثبات القانون الأجنبي عن طريق تقديم نصوص القانون الأجنبي نفسها أو ترجمتها.
(هشام صادق، مرجع سابق ص 238)
الحلول القانونية عند استحالة تحديد القانون الأجنبي
التزام القاضي بالبحث عن مضمون القانون الأجنبي ينتهي في الأحوال التي يستحيل فيها التوصل إلى الكشف عن أحكام هذا القانون.
وقد تنوعت الاتجاهات الفقهية التي واجهت هذا الفرض فمنهم من ذهب إلى الامتناع عن الفصل في النزاع وذلك لتعذر الكشف عن أحكام القانون.
وقد انتقد هذا الرأى لتعارض مع المبادئ العامة في قانون المرافعات ولأن القاضي ملزم دائما بالبحث عن القاعدة الواجبة التطبيق حتى ولو لم يكن هناك نص.
وذهب رأى آخر لتطبيق المبادئ العامة السائدة في الأمم المتمدينة تأسيسا على افتراض تطابق القانون الأجنبي مع هذه المبادئ.
إلا أن هذا الرأى قد تم انتقاده لأنه يفتقر إلى السند القانوني كما يفوض القاضي سلطات واسعة تؤدي للتحكم.
وذهب اتجاه آخر لتطبيق القانون الأقرب في أحكامه إلى القانون الذي تعذر الكشف عن مضمونه .
فإذا أشارت قاعدة الإسناد بتطبيق القانون الأمريكي وتعذر على القاضي الكشف عن مضمونه.
فله أن يطبق القانون الإنجليزي باعتباره من نفس (العائلة القانونية).
وقد انتقد هذا الرأى على أنه من المستحيل أو الصعب التقارب بين التشريعات المختلفة.
وقد ذهب رأى آخر الى تطبيق قانون القاضي عند تعذر الكشف عن أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق.
وقد انتقد هذا الرأى بدوره لأنه يقوم على أساس خاطئ، فليس صحيحا أن القانون الوطني هو صاحب الاختصاص العام لحكم علاقات القانون الخاص حتى لو تضمنت عنصرا أجنبيا.
ذلك أن طبيعة العلاقات الدولية تتنافى مع القول بالولاية العامة للقانون الوطني.
فالأصل في مجال العلاقات الخاصة الدولية هو تطبيق القانون الذي تشير قواعد الإسناد باختصاصه وطنيا كان أم أجنبيا
(د/ مصطفى كامل ياسين ص 552، 553)
وقد ذهب رأى آخر الى تطبيق القانون الأكثر ارتباطا بالمسألة المعروضة بعد القانون الذي تعذر الكشف عن مضمونه.
وأساس هذا النظر هو أن المشرع بهدف من وراء قواعد الإسناد الى إخضاع العلاقات الدولية الى أكثر القوانين ارتباطا بها، وأقدرها بهذا الوصف على تحقيق العدالة من وجهة نظره.
فإن تعذر الكشف عن مضمون هذا القانون، فإن الأقرب الى حكمة التشريع هو تطبيق أكثر القوانين الأخرى ارتباطا بالنزاع، سواء كان قانونا أجنبيا أم قانون القاضي نفسه.
وللقاضي في هذا السبيل أن يستهدي بالمبادئ العامة في التنازع السائدة في قانونه، ليكشف من خلالها عن اقرب الحلول الى هذه المبادئ وأكثرها تحقيقا للهدف الذي تسعى إليه.
(هشام صادق، مرجع سابق)
وقد انتقد هذا الرأى على أساس أنه يتوخى القاضي سلطة التشريع ويمنحه القدرة على وضع قاعدة إسناد احتياطية في الفروض التي يتعذر فيها الكشف عن مضمون القانون المختص بمقتضى قاعدة الإسناد الأصلية .
والخلاصة أنه:
لو تعذر الكشف عن أحكام القانون المختص بموجب قاعدة الإسناد الأصلية فإن مراعاة حكمة التشريع وطبيعة العلاقة الدولية محل البحث يحتم القول بتطبيق أكثر القوانين ملائمة لهذه العلاقة بعد القانون الذي تعذر التوصل إلى مضمونه.
وسواء كان هذا القانون هو قانون القاضي أو أى قانون آخر، فهذا الاتجاه الذي يتسم بالمرونة ويتلاءم مع طبيعة العلاقات الدولية، يتلافى أوجه النقد الموجهة إلى الفكرة التقليدية في شأن التطبيق الجامد لقانون القاضي في جميع الأحوال.
دون أن يستبعد مع ذلك إمكانية هذا التطبيق، فقد يكون قانون القاضي هو الأقرب إلى طبيعة العلاقة بعد القانون الذي تعذر الكشف عن أحكامه.
بل قد يضطر القضاء إلى تطبيق قانونه في النهاية إذا ما تعذر عليه التوصل أيضا إلى مضمون القانون أو القوانين الأكثر اقترابا إلى طبيعة العلاقة بعد القانون الذي أشارت قاعدة الإسناد الأصلية باختصاصه والذي تعذر الكشف عن مضمونه.
فقانون القاضي بعد، على الأقل، قانون المحكمة التي طرح النزاع أمامها، وهو، بهذه الصفة، لا يعد غريبا تماما عن النزاع في كثير من الفروض.
(شمس الدين الوكيل، مرجع سابق، هشام صادق مرجع سابق)
دور القاضي المصري في تفسير وتطبيق القانون الأجنبي
دور القاضي في تفسير القانون الأجنبي على هذا النحو لا يختلف كثيرا عن دوره عند تفسير قانونه، فحتى في هذا المجال الأخير فهو يتقيد عملا بما توافر عليه القضاء المستقر في دولته.
ومن جهة أخرى فقد يمتلك القاضي حرية نسبية في تفسير النصوص الأجنبية في الأحوال التي يتبين له فيها تضارب القضاء الأجنبي حول حقيقة مضمونها وعدم استقراره على تفسير معين لها.
ونشير في النهاية إلى الفرض الذي قد يستقر فيه القضاء في دولة القاضي على تفسير قاعدة أجنبية معينة على نحو يخالف ما انتهى إليه تطور القضاء الأجنبي نفسه في تفسير هذه القاعدة.
ونحن لا نتردد في هذه الحالة في تحويل القاضي الوطني حق الخروج عن الحلول القضائية المستقرة في دولته، والانصياع الى التفسير السائد لدى قضاء الدولة التي يطبق قانونها .
(هشام صادق، مرجع سابق)
خضوع قاضي الموضوع في تطبيقه للقانون الأجنبي لرقابة محكمة النقض:
اتجهت محكمة النقض إلى فرض رقابتها على تفسير القوانين الأجنبية وبالتالي يخضع لقاضي الموضوع في تطبيقه للقانون الأجنبي لرقابة محكمة النقض .
(انظر هشام صادق بند 79)
تعريف التكييف وفقا للقانون المصري وأثره في تحديد القانون الواجب التطبيق
المقصود بالتكييف الذي يخضع للقانون المصري هو التكييف الأولى أو السابق.
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون بأن:
تطبيق القانون المصري بوصفه قانونا للقاضي في مسال التكييف لا يتناول إلا تحديد طبيعة العلاقات في النزاع المطروح لإدخالها في نطاق طائفة من طوائف النظم القانونية التي تعين لها قواعد الإسناد اختصاصا تشريعيا معينا لطائفة النظم الخاصة بشكل التصرفات أو بحالة الأشخاص …. الخ.
ولا يكون للقاضي إلا أن يعمل أحكام هذا القانون
(مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 235 وما بعدها)
والمقصود بالقانون المصري :
المبادئ العامة في هذا القانون أيا كان مصدرها، وبذلك يمكن القول أن القاضي يستهدي بالأصول العامة والمبادئ السائدة في القانون المصري دون التقيد فقط بما ورد بالنصوص.
فإذا تضمنت النصوص التشريعية تكييف معين للمسألة المعروضة، فلا شك أن القاضي يكون ملزما في هذه الحالة بالأخذ بهذا التكييف . أما إذا لم تتضمن النصوص تكييف معين للمسألة المعروضة، كما هو الوضع الغالب.
فيكون على القاضي أن يحدد طبيعة هذه المسألة وفقا للمبادئ العامة في قانونه، وفي سبيل القيام بهذه المهمة، فإن القاضي لا يتقيد بوضع النص في قانون أو مكان معين،
“فوجود قاعدة متعلقة بالإثبات في القانون المدني لا يمنع من اعتبارها متعلقة بمضمون فكرة الشكل في القانون الدولي الخاص ووجود قاعدة معينة في قانون المرافعات لا يمنع من وصفها قاعدة موضوعية عند تفسير قاعدة الإسناد”
(شمس الدين الوكيل ص 58)
وبالمثل فإنه بالنسبة لمواد الأحوال الشخصية والتي يطبق القضاء في شأنها قوانين متعددة، فإن تحديد طبيعة المسألة المعروضة يتم الرجوع الى القانون المصري في جملته دون التقيد بقانون أو بآخر من القوانين المعمول بها في مصر
(د/ منصور مصطفى ص 81)
وعلى ذلك يمكن القول بأن القاضي لا يتقيد بما جاء بنصوص التشريع إلا إذا قامت هذه النصوص بمهمة التكييف ، وهو ما لا يحدث إلا نادرا .
أما إذا تصدى القاضي بنفسه لمهمة التكييف في غير هذه الحالة الاستثنائية فهو لا يتقيد بوضع النص في قانون معين أو في مكان معين من تقسيمات هذا القانون.
وغني عن البيان أن حرية القاضي عند سكوت النصوص عن القيام بمهمة التكييف ليست مطلقة، بل إن القاضي مقيد بعدم الخروج في تكييفه للمسالة المعروضة عن المفاهيم المستمدة من المبادئ العامة في القانون المصري.
ومن هنا يختلف مسلك القاضي عند إجراء التكييف على هذا النحو عن مسلكه الذي تمناه الأستاذ كوادري، فقد مضت الإشارة الى أن الأستاذ الإيطالي يرى أن تكييف العلاقة يخضع لعلم القانون مجردا عن تصور القوانين الوضعية له.
(منصور مصطفى منصور رقم 420)
ونخلص في النهاية الى أن:
الفقه المصري قد انتهى بحق الى أن المقصود بالقانون المصري الذي يرجع إليه في شأن التكييف وفقا لمفهوم المادة العاشرة من القانون المدني هو المبادئ العامة والأصول الجامعة للقانون المصري.
وقد أكدت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني هذا المعنى فجاء بها:
“وينبغي أن يفهم من رجوع المحاكم المصرية الى قانونها في مسائل التكييف إلزامها بالرجوع الى القانون المصري في جملته – بما يتضمن من قواعد تتعلق بالأشخاص وبالأموال أيا كان مصدر هذه القواعد .
دون أن تقتصر على الأحكام التي تختص بتطبيقها وفقا لتوزيع ولاية القضاء “
(مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 234)
إخضاع التكييف لقانون القاضي: تفسير لا يعني تجاهل القانون الأجنبي
إخضاع التكييف لقانون القاضي لا يعني تجاهل القانون الأجنبي الذي تمسك الخصوم بأحكامه، أو المحتمل التطبيق، ذلك أن الوقوف على حقيقة العلاقة المطروحة أمام القضاء لا يتأتى إلا بالرجوع الى أحكام القانون الأجنبي الذي تمسك الخصوم بنصوصه.
وعلى هذا النحو يمكن للقاضي أن يكشف عن الملامح الأساسية للعلاقة والمركز محل البحث
(شمس الدين الوكيل ص 57)
وذهب رأى الى أن الرجوع الى القانون الأجنبي والاستئناس بأحكامه في هذه الحالة لا يعد استثناء على قاعدة خضوع التكييف لقانون القاضي .
ذلك أن الكشف عن طبيعة المركز المطروح أمام القضاء يقتضي بداهة أن نتلمس أولا المعالم الأساسية لهذا المركز وفقا لأحكام القانون الذي يستند إليه.
وإذا ما تم للقاضي الاستئناس بالقانون الأجنبي على هذا النحو، أمكنه بعد ذلك أن يرد المسألة المعروضة – بعد أن برزت معالمها – الى الفكرة المسندة الملائمة لها في قانونه.
ويستلزم ذلك من القاضي أن يكشف عن مضمون الفكرة المسندة ليتبين مدى تضمنها للعلاقة المطروحة أمامه.
وهذه هى مرحلة التكييف الذي يخضع للقانون المصري، بوصفه قانون القاضي، وفقا للحكم الوارد بالمادة العاشرة من القانون المدني .
(د/ هشام صادق، مرجع سابق)
إخضاع التكييف للقانون المصري: الفرق عن قاعدة الإسناد وتفسيرها
إخضاع التكييف للقانون المصري على النحو السالف لا يعني بالضرورة تطابق الفكرة الواردة في قاعدة الإسناد مع التصوير السائد عن هذه الفكرة في القانون الداخلي.
“ولئن كان الأصل هو تماثل معنى الفكرة الواحدة بالنسبة للقانون الدولي الخاص والقانون الداخلي، إلا أنه ليس هناك ما يمنع في بعض الأحيان من تغيير معنى الفكرة عند تفسير قاعدة الإسناد”
(شمس الدين الوكيل ص 57)
فقد مضت الإشارة الى أن فكرة شكل التصرفات مثلا قد تتخذ معنى يختلف في القانون الدولي الخاص عنه في القانون الداخلي استجابة للاعتبارات الدولية،
فقد رأينا أن الأساس الذي تقوم عليه قاعدة إخضاع شكل التصرف لقانون بلد إبرامه في القانون الدولي الخاص هو التيسير على المتعاقدين إزاء الصعوبات العملية التي قد تصادفهم في التعرف على الأحكام القانونية الخاصة بالشكل في قانون دولة غير تلك التي تم فيها العقد.
وهذا الاعتبار الغريب عن العلاقات الداخلية يبرر التوسع في مضمون فكرة الشكل في القانون الدولي الخاص .
(منصور مصطفي منصور ص 82)
ويرجع الاختلاف المتصور بين مضمون الفكرة المسندة في القانون الدولي الخاص عن المفهوم السائد عن هذه الفكرة في القانون الداخلي في رأى الفقه المصري الى اعتبار هام سبق الفقه الفرنسي الحديث أن نبه الأذهان إليه،
ذلك أن قواعد التنازع وضعت لمواجهة علاقات دولية وهذه العلاقات ليست مماثلة تماما للعلاقات الداخلية وهو ما يستتبع عدم لزوج وحدة الفكرة في النطاقين .
(منصور مصطفي منصور ص 82)
ولهذه الاعتبارات لم يتردد الفقه المصري – أسوة بالفقه الفرنسي – في تأكيد ضرورة الاستعانة بالقانون المقارن للتوسع في مفهوم قانون القاضي استجابة للاعتبارات الدولية، وتمشيا مع وظيفة قواعد الإسناد.
(شمس الدين الوكيل ص 57، هشام صادق ص 152، منصور مصطفى منصور ص 83)
ضرورة تطبيق القانون المصري في تكييف العلاقات القانونية
المشرع المصري قد استخدم في المادة العاشرة صياغة مرنة تسمح بهذا التوسع، فقد جاء في هذه المادة أن القانون المصري هو (المرجع) في التكييف،
“ولفظ المرجع ليس فيه الجمود الذي كان يمكن أن يتوافر في النص، إذا جاء مقررا أن القانون المصري هو الواجب التطبيق في تكييف العلاقات “
(شمس الدين الوكيل، مرجع سابق ص 58)
المساواة بين المنقولات والعقارات في تحديد القانون الواجب التطبيق وفقًا للمشرع
المشرع قد سوى بين المنقولات والعقارات بالنسبة للقانون الواجب التطبيق في شأن الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى، فأخضعها في الحالتين لقانون الجهة التي يوجد بها المال.
وعلى هذا النحو فإذا تصدى القاضي لإعمال قاعدة الإسناد الواردة بالمادة 18 من القانون المدني، فعليه أن يقوم بتكييف المسألة المعروضة وفقا للقانون المصري ليرى ما إذا كانت تدخل في مضمون فكرة الحقوق العينية من عدمه.
فإذا تبين للقاضي أن العلاقة المطروحة أمامه مما يندرج في فكرة الحق العيني، فإن تحديد وصف المال بعد ذلك يخضع بداهة لقانون الموقع، لا على سبيل الاستثناء من القاعدة العامة، وإنما بوصفه تكييفا ثانويا أو لاحقا .
(هشام صادق، مرجع سابق)
أمثلة من أحكام القضاء في تطبيق القانون الأجنبي
المرجع فى تكييف ما إذا كانت المسألة المعروضة على المحكمة هى من مسائل الأحوال الشخصية، ام هى ليست كذلك، هو القانون المصرى وفقا للمادة 10 من القانون المدنى.
(جلسة 26/3/1953 – مجموعة المكتب الفني – السنة 4 – مدني – العدد 1 ص 270 )
خلاصة شرح نص المادة 10 من القانون المدني المصري
المادة 10 من القانون المدني المصري تنص على:
“القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.”
هذا النص يمكن الاطلاع عليه رسميًا على المواقع الحكومية كالموسوعة القانونية لوزارة العدل المصرية وقواعد التشريعات القومية.
أهم أحكام وقواعد القانون الدولي الخاص المصري في قضايا تنازع القوانين
المادة 18 تنص على أن:
الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى تتبع قانون الموقع بالنسبة للعقار، أما المنقول فيتبع قانون الجهة التي يوجد بها وقت تحقق السبب القانوني.
المادة 19 تشير إلى أن:
الالتزامات التعاقدية تكون خاضعة لقانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين فإذا اختلفا موطناً كان المرجع قانون الدولة التي تم فيها العقد، مع بعض الاستثناءات مثل العقود المتعلقة بالعقارات.
التطبيق القضائي في القضايا ذات العنصر الأجنبي
في نطاق القانون الدولي الخاص، يبرز موضوع تنازع القوانين كأحد أهم المبادئ التي تواجه المحاكم عند دراسة القضايا ذات العنصر الأجنبي.
وتتعلق هذه الظاهرة بتعدد القوانين التي يمكن أن تحكم علاقة قانونية معينة، مما يثير سؤالًا جوهريًا حول القانون الواجب التطبيق.
وفي مصر، ينص القانون المدني، وخاصة المادة 10، على مبادئ واضحة بشأن تحديد القانون المصري كمرجع في تكييف العلاقات القانونية في حالات تنازع القوانين من حيث المكان.
مفهوم تنازع القوانين من حيث المكان وأثره في النظام القانوني
تنازع القوانين يعني وجود أكثر من قانون دولي أو محلي قد يطبق على حالة قانونية واحدة بسبب وجود عنصر أجنبي في طرف من أطراف النزاع أو موضوعه.
ويُقصد بعبارة “تنازع القوانين من حيث المكان” الجانب الجغرافي الذي يُحدد القانون المناط به الحكم في النزاع.
في القانون المصري، تستخدم قواعد القانون الدولي الخاص لتحديد:
- المحكمة المختصة بنظر الدعوى (اختصاص قضائي).
- القانون الواجب التطبيق على النزاع (قانون الموضوع).
وهذه القواعد لا تنظم موضوع النزاع بذاته، بل توجه القاضي إلى القانون المناسب للفصل في النزاع.
التأطير التشريعي في القانون المصري: المادة 10 من القانون المدني
تنص المادة 10 من القانون المدني المصري على أن:
“القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.”
أي أن القانون المصري هو المرجع الأول لمعرفة طبيعة العلاقة القانونية محل النزاع، أي أن القاضي المصري يجب أن يحدد طبيعة ومسألة العلاقة وفقًا لمبادئ القانون الوطني.
تفصيل المادة 10 من القانون المدني المصري
تكييف العلاقة القانونية: هو مرحلة أولى ضرورية لتحديد أي قانون من القوانين المتنازعة هو الذي سيطبق في النزاع.
رجوع القاضي للقانون المصري: يلتزم القاضي المصري بتطبيق قواعد القانون المصري في التكييف، أي تصنيف العلاقة القانونية (عقود، ميراث، أحوال شخصية، حقوق عينية…).
الفصل بين التكييف وقاعدة الإسناد: بعد التكييف، يتم تطبيق قواعد الإسناد التي تحيل إلى القانون المختص بالنظر أو التطبيق، سواء كان مصرياً أو أجنبياً.
استثناءات: قامت المادة باستثناء تحديد صفة العقار أو المنقول، حيث تُرجع هذه لتطبيق اعتبارات عملية متعلقة بموقع المال.
أهمية المادة 10 في مواجهة تعدد القوانين
المادة 10 لها دور حاسم في تحديد هل العلاقة موضوع النزاع أُدخلت ضمن تصنيف القانون المصري، مما يضمن تحقق العدالة وحماية سيادة القانون الوطني في مرحلة التكييف.
وهذا ما يؤكدته المذاهب الفقهية الحديثة والقضاء المصري، لا سيما محكمة النقض.
قواعد القانون الدولي الخاص وموقعها من تنازع القوانين في مصر
يشتمل القانون المدني المصري على مجموعة مواد (من 10 إلى 28) تخص قواعد الإسناد، وهي القواعد التي توجه القاضي لتطبيق القانون المنوط به بحسب نوع العلاقة القانونية وعناصر النزاع.
طبيعة قواعد الإسناد
- قواعد الإسناد ليست قواعد موضوعية وإنما قواعد تأهيل وإسناد توجه القاضي لتحديد القانون المناسب.
- تنظم كيفية تطبيق القانون الوطني أو الأجنبي، لا تنظيم العلاقات القانونية نفسها.
- تهدف إلى تحقيق الملائمة والعدالة في الحكم، بتطبيق القانون الأكثر ارتباطًا بالنزاع.
دور التكييف في تطبيق قواعد الإسناد
- لا يمكن تطبيق قواعد الإسناد دون تحديد طبيعة العلاقة أولاً (التكييف).
- يظل القانون المصري هو المرجع في تكييف هذه العلاقة كما نصّت المادة 10.
- بعد التكييف، تستند قواعد الإسناد لتحديد القانون الواجب التطبيق.
تطبيق القانون الأجنبي في القانون المصري
- عندما تعطي قواعد الإسناد أولوية لتطبيق القانون الأجنبي:
- على القاضي المصري استقراء مضمون القانون الأجنبي المستخدم.
- استعمال جميع وسائل العلم للتعرف على القانون الأجنبي، مع استبعاد الاعتراف واليمين كوسائل لإثبات القانون.
- تقديم نصوص القانون الأجنبي أو الترجمات هو الطريقة العملية لإثباته.
- إذا تعذر الكشف عن القانون الأجنبي، يتخذ القضاء قرارات وفق اتجاهات فقهية لاستخدام أكثر القوانين ارتباطًا أو حتى قانون القاضي كحل احتياطي.
دور القضاء المصري وقرارات محكمة النقض
النظام القضائي في مصر يؤكد التنفيذ الدقيق لمبادئ المادة 10:
- مرجع التكييف هي المبادئ العامة للقانون المصري بغض النظر عن التشريعات الفرعية.
- لا يجوز للقاضي التحايل على القانون المصري أو الابتعاد عنه بتكييف العلاقة.
- لا يعني إخضاع التكييف للقانون المصري تجاهل أحكام أو نصوص القانون الأجنبي وإنما الاستعانة بها لفهم طبيعة النزاع.
- تخضع قضايا تطبيق القانون الأجنبي لرقابة محكمة النقض لضمان تفسير موحد ومتسق.
خلاصة:
- تنازع القوانين من حيث المكان في مصر يخضع لمبادئ القانون الدولي الخاص وأساسه المادة 10 من القانون المدني المصري.
- المادة 10 تلزم المحاكم المصرية بالرجوع للقانون المصري في تكييف النزاعات ذات العنصر الأجنبي لتحديد طبيعة العلاقة القانونية.
- بعد التكييف، تُطبق قواعد الإسناد لتحديد القانون الواجب التطبيق سواء كان القانون مصريًا أو أجنبيًا.
- التطبيق العملي يُظهر أن القانون المصري يحكم مسألة التكييف بالدرجة الأولى مع مراعاة إطار القانون الدولي الخاص والمبادئ القانونية العالمية.
- دور القضاء المصري ومحكمة النقض حاسم في ضبط تنفيذ هذه المبادئ وضمان العدالة.
أشهر الأسئلة المتداولة حول تنازع القوانين مع إجابات دقيقة مشروحة
هل يحق للوريث الطعن على البيع الصادر من المورث في حالة وجود عنصر أجنبي؟
كيف يثبت القاضي المصري مضمون القانون الأجنبي الواجب التطبيق؟
ما الحل إذا استحال الكشف عن مضمون القانون الأجنبي؟
هل إخضاع التكييف لقانون القاضي يعني تجاهل القانون الأجنبي؟
هل تختلف فكرة الشكل القانوني بين القانون المصري والدولي الخاص؟
هل تخضع منازعات الجنسية والموطن لمادة التنازع؟
ما هي قواعد الإسناد؟
هل يمكن تطبيق القانون المصري على القضايا ذات العنصر الأجنبي؟
ما هو التكييف الذي يخضع له النزاع؟
هل يتعين على القاضي الرجوع إلى القانون الأجنبي؟
ما هي أهمية المادة 10 في القانون المدني؟
ما هي الحالات التي يطبق فيها القانون الأجنبي؟
مراجع قانونية رسمية
- الموسوعة القانونية الرسمية وزارة العدل المصرية
- موسوعة التشريعات القانونية لوزارة العدل المصرية.
- القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 مع تعديلاته.
- المواد 10 إلى 28 من القانون المدني المصري.
- مجموعات الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري.
- أحكام محكمة النقض المصرية ذات الصلة بتكييف القوانين.
تنويه: انتهي البحث القانوني ويستند إلى المصادر الحكومية المصرية الرسمية، وقدمنا شرحًا واضحًا لبنية قانون تنازع القوانين في مصر من حيث المكان، مع التركيز على المادة 10 وأهميتها في تحديد القانون الواجب التطبيق.
في النهاية، يتضح أن تحديد القانون الواجب التطبيق في قضايا تنازع القوانين يتطلب أن يسترشد القاضي بالقواعد المصرية للتكييف وفقًا للمادة 10 من القانون المدني.
إذ تضمن هذه المادة تنظيمًا دقيقًا لتنازع القوانين، ما يساهم في إيجاد الحل الأنسب لكل حالة على حدة. إذا كنت تواجه نزاعًا قانونيًا يتطلب تحديد القانون الواجب التطبيق.
لذلك، إذا كانت لديك قضية تتعلق بتنازع القوانين أو تحتاج إلى استشارة قانونية متخصصة، لا تتردد في التواصل معنا عبر نموذج الاستشارة المجانية.
فريقنا من المحامين المتخصصين في القانون الدولي الخاص جاهز لتقديم الحل الأمثل لقضيتك.
إذا كان لديك أي استفسار قانوني، يمكننا مساعدتك في الحصول على استشارة دقيقة لضمان تحقيق العدالة.
تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة
هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟
مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.
📞 اتصل مباشرة لحجز موعد بالمكتب: 01285743047
📱 راسلنا على واتساب للاستفسارات السريعة: 01228890370
📧 البريد الإلكتروني: azizamar90@gmail.com
🏠 العنوان: 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس – الزقازيق – محافظة الشرقية – مصر
💬📩 أرسل استشارتك الآن عبر نموذج التواصل .
⏰ مواعيد العمل:
- من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق
- الخميس والجمعة: أجازة للمكتب – الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد
⚖️ خدماتنا القانونية:
1️⃣ الأفراد والعائلات:تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.
- قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
- صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
- قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).
2️⃣ الشركات والمؤسسات:
- تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
- التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
- التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
- التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.
3️⃣ خدمات مخصصة:
- إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
- استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
- حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.
لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟
❓ لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟
💼 خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية
📊 تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف
📈 التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة
🌐 تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية
🔔 اشترك للحصول على دليل مجاني حول قانون الميراث والعقارات .
📝 استشارتك الأولى تبدأ بخطوة … راسلنا الآن بثقة
“إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر.”
تاريخ النشر: 2025-09-02
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2025/09/تنازع-القوانين-من-حيث-المكان-في-القانو.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2025-09-02.